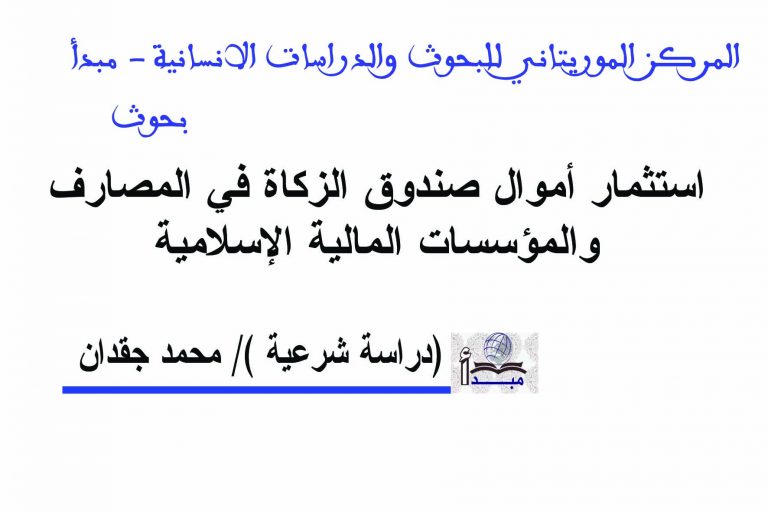الدكتور مروان شحاتة
الملحُ يأتي من الشمال
والذهبُ من الجنوب
والفضة من بلد البيضان
أمّا كلام الله والأشياء المقدسة
والقصص الجميلة
لا توجدُ إلا في تمبكتو
Salt comes from the North, Gold from the South, Money from White man country, but God words, holy things, interesting tales, we can find them only in Timbuktu

le Sel vient du Nord; L’or du sud, l’argent du pays des blancs, mais la Parola de Dieu les choses savante les jolis contes on ne les trouve qu’a Tombouctou
مستقبل الجماعات المسلحة في مالي والساحل

يبدو أن الزيارات الميدانية لجمهورية مالي، تساهم في زيادة فهم طبيعة الصراع المسلح المتواصل منذ سنوات طويلة في غرب إفريقيا والساحل، ومعرفة مستقبل المنطقة، وتساعد هذه الزيارات كذلك على فتح قنوات اتصال مع القوى الفاعلة في المشهد المالي بمختلف أطيافها.
وحيث أن محاولة الفهم هذه تصب في جانب عمل المنظمات الدولية الإنسانية المُحايدة، وعلى رأسها منظمة أطباء بلا حدود، والتي تهدف إلى كسر الهوة ما بين المنظمات والأطراف المختلفة وبخاصة الجماعات المسلحة، لضمان سلامة العاملين فيها وتسهيل عملها.
فقد اختلفت زيارتي الأخيرة التي امتدت من 22 شباط/ فبراير 2018 ولغاية 13 آذار/ مارس 2018، عن الزيارة السابقة، بأنني تمكنت من التنقل براً وجواً، في الصحراء المالية للوصول إلى بعض المدن التي تشهد حضوراً قوياً للجماعات المسلحة، حيث قمت بزيارة المدن التالية: تننكو، موبتي، تمبكتو.
ولا تختلف الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية بين معظم المقاطعات المالية وبخاصة في المناطق الشمالية، فالطرق الرئيسية غير آمنة للتنقل والسفر، ولا تخلو من قطاع الطرق، الذين يقومون بالاعتداء على المسافرين وأخذ أملاكهم وسياراتهم وفي بعض الحالات اختطافهم وتسليمهم للجماعات المسلحة أو التفاوض لإطلاق سراحهم مقابل فدية معينة.
وللمرة الأولى، كان لي فرصة بلقاء بعض المقاتلين الذين ينتمون لـ “جبهة تحرير ماسينا”([1])، وكذلك فتح قنوات اتصال مع الجماعات المسلحة، ولقاء نخب فكرية إسلامية إفريقية وقيادات وطنية وعسكرية، وزيارة بعض مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية، وعلى رأسها منظمة الفاروق، واتحاد علماء إفريقيا وجامعة الساحل.
لم يكن التدخل الفرنسي وغيره من القوى العالمية في أفريقيا عموماً ومالي على وجه الخصوص الأول من نوعه، ولا يخفى على أحد أن فرنسا تعيد إنتاج سيطرتها ونفوذها على معظم دول إفريقيا، بل يمكن القول بأنها لم تفقد تلك السيطرة والنفوذ رغم تغير أنظمة الحكم في العديد من الدول الأفريقية.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو لماذا ما زالت فرنسا مهتمة بالسيطرة على إفريقيا وترفض منافسة الدول الغربية الأخرى، كأمريكا وبريطانيا في الحصول على حصة من النفوذ في تلك البلدان؟ ولعل الجواب المباشر الذي حاولت مجلة قراءات أفريقية طرحه لقرائها بأن فرنسا ” ظلت تنهب خيرات إفريقيا طول فترة احتلالها، ولا زالت تسيطر على مناجم الماس والذهب والمعادن واليورانيوم، وحينما خرجت فرنسا من القارة تركت الدول التي كانت تحتلها بعد استقلال موهوم، تعيش في صراع سياسي، وتخلّف إداري واقتصادي، أبقاها في ذيل الشعوب والأمم”([2]).
يبدو أن الأزمة المالية([3])، ما زالت تعيش في أتون الصراع السياسي والعسكري بين الحكومة المركزية في الجنوب وجماعات قومية وإسلامية، عبر سنوات طويلة راوحت بين الثورة والإتفاق، منذ أن بدأت الحراكات الشعبية التي تطالب باستقلال إقليم أزواد شمالي البلاد عن الحكومة المركزية، وما زالت الظروف الموضوعية والذاتية التي دفعت بالكثيرين للخروج في وجه الدولة قائمة إلى يومنا الحاضر، رغم إتفاقيات السلام المتتالية التي وقعت بين الأطراف المتنازعة.
خارطة الجماعات في المشهد المالي:
هناك اتجاهان يغلبان على الحراك الشمالي، وبقية مقاطعات مالي، الأول يستند إلى طروحات قومية، هدفها إقامة دولة علمانية للطوارق في الشمال، تمثلت في تأسيس “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، والثاني اتجاه يسعى لإقامة إمارة إسلامية وتطبيق الشريعة، تمثل في تأسيس عدد من الجماعات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها جماعة أنصار الدين، بزعامة إياد أغ عالي، و” حركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا”، بزعامة سلطان ولد بادي، وهو من القيادات العربية في أزواد، وكتيبة الملثمين التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتغير اسمها إلى المرابطون ثم الموقعون بالدماء، وهي بزعامة مختار بلمختار، وجماعة أنصار الشريعة في تمبكتو، بزعامة ” عمر ولد حماه” ([4]).
وقد دخلت هذه الجماعات في أطوار تتعلق بتغيير تحالفاتها ومسمياتها، وبخاصة تلك التي ترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث آلت التسمية إلى جماعتين رئيسيتين: ” إمارة منطقة الصحراء الكبرى”، و” تنظيم المرابطون”، وفي 2 آذار / مارس 2017 أعلنت معظم التنظيمات الإسلامية المسلحة اندماجها في جماعة واحدة تحت مسمى جديد هو ” جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، واختير إياد أغ غالي زعيماً لها([5]).
يشير إعلان كلٍّ من “إمارة منطقة الصحراء الكبرى” و”تنظيم المرابطون” و”جماعة أنصار الدين” و”جبهة تحرير ماسينا”، في 2 مارس 2017، عن تأسيس تحالف جديد باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، واختيار إياد أغ غالي -زعيم “جماعة أنصار الدين”- قائدًا له، إلى سعى “تنظيم القاعدة”-الذي بايعته تلك التنظيمات- نحو تعزيز نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية في منطقة الساحل والصحراء من جديد، في رسالة إلى كل من تنظيم “داعش”-المنافس الرئيسي لـ”القاعدة”- والقوى المعنية بالحرب ضد الإرهاب وفي مقدمتها فرنسا التي شنت عملية عسكرية لإخراج عناصر بعض تلك التنظيمات من شمال مالي في بداية عام 2013.
وربما جاء إعلان إندماج الجماعات الإسلامية المسلحة – الجهادية – في الساحل والصحراء؛ بفعل المواجهة الشرسة التي تخوضها هذه الجماعات متفرقة مع القوات الفرنسية والغربية والمحلية، وبسبب التنافس الكبير على السيطرة والنفوذ بين تنظيمي ” القاعدة ” و” الدولة الإسلامية ” في مناطق العالم، والتي بدأت في العراق وسوريا وانتقلت إلى بقية مناطق انتشار تنظيم القاعدة في اليمن والشمال والغرب الأفريقي وأفغانستان والفلبين، وأوروبا.
ومن المرجح أن يكون التشكيل الجديد الذي جاء تحت مسمى ” جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ” بزعامة الشيخ إياد إغ غالي، والذي يعتبر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ممثلاُ وجزءً منه، يحاول أن يكون وطنياً في الداخل المالي وفي معظم إفريقيا، وأن حدود انتشار نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنحصر في المغرب الإسلامي ولا تتعداه إلى غرب ووسط إفريقيا[6].
ويبدو أن هذان الاتجاهان يستخدمان ذريعة من قبل الدول للتدخل في الشأن المالي، ففي الوقت الذي يستخدم الاتجاه الأول – العلماني والعرقي – بتلقي الدعم من المُستعمِر لدوره في مواجهة الهوية الإسلامية في إقليم أزواد، وتفتيت الجهود الرامية إلى توحيد الجهود من جهة، وفي الجهة الثانية يستخدم الاتجاه الثاني – الإسلامي- ذريعة للتدخل تحت شعار الحرب على الإرهاب([7]).
ويمكن تقسيم التجمعات أو التحالفات التي وقعت إتفاقية الجزائر التي تمثل الحركات السياسية في إقليم أزواد إلى قسمين الأول: البلاتفورم ( Platform)، الذي يتكون من ثلاث حركات رئيسية: حركة الدفاع الذاتي، والحركة العربية الأزوادية، وحركة غاتيا وحلفائها، وكل حركة تمثل قومية معينة.
يعتبر مؤيدوا ” القاعدة الشعبية العريضة ” أو ما اشتهر باسم ” البلاتفورم” بأنها صحوة إيجابية فاعلة في المجتمع الأزوادي، تتشكل من القوميات الثلاث في الشمال: السونغاي والعرب والطوارق، وتاريخيا الشعوب الصحراوية تمتلك اسلحة، من خلال السوق السوداء، والبلاتفورم ترسم استراتيجيتها للحفاظ على النسيج المختلف في المجتمع، وبخاصة الشعوب العربية في الصحراء الكبرى، التي تمتد من حدود موريتانيا والجزائر والنيجر وغيرها[8].
والقسم الثاني: يسمى تنسيقية الحركات الأزوادية ( CMA)، وتضم: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وجناح الحركة العربية المعارض.
عهد ” الأمان”:
تعتبر الجماعات الإسلامية المسلحة أن غياب للدولة ” الإسلامية ” التي ترعي تنظيم العلاقات الدولية مع الآخر على مستوى الجماعات والدول والأفراد سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية، وأن مسألة تقسيم العالم لدى هذه الجماعات يحيطه خلاف اجتهادي حول طبيعة هذا التقسيم ( دار إسلام، دار كُفر، دار حرب، دار عهد) بسبب هذا الغياب، وقد اجتهدت هذه الجماعات على اعتبار انها قادرة على اصدار الأحكام الشرعية من خلال فتاوى علمائها في مسألة معاصرة كتقسيم الدار أو الدول، وكذلك العهود التي تعطى ومن يعطيها، ومسائل أحكام الحرب والقتال، ولا ينحصر مناقشة تلك المسائل الفقهية لدى الجماعات المسلحة بل لا يخلو فيها كتاب فقهي قديم أو معاصر من تناولها.
وحيث أن تقسيم القانون الدولي الإنساني لطبيعة النزاعات المسلحة التي تدور في مناطق متعددة من العالم، هو: ” نزاع مسلح غير دولي”[9]، فسوف نحاول فيما يلي تسليط الضوء على جزئية عهد ” الأمان” الذي تعطيه بعض الجماعات للآخر، ونطلع على نماذج للشروط التي تضعها تلك الجماعات.
ومن المعروف أن المعاهدات؛ هي الاتفاقات أو الموادعات أو المواثيق التي تعقدها الدولة ” الإسلامية” مع غيرها من الدول لتنظيم العلاقات الدولية بينها، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة، وعرفها الفقهاء بقولهم : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، وتسمى موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادنة، وهي مشروعة وعقدها مع غير المسلمين جائز بموجب النصوص القرآنية والسنة النبوية سواء لمصلحة المسلمين أو بحكم ضرورة طارئة أو بسبب نكبة حلت بالمسلمين، ومن المعاهدات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم المعاهدة المشهورة المعروفة باسم صلح الحديبية، وعقدت مع أهل مكة في السنة السادسة من الهجرة، وقد سار الخلفاء المسلمين على خطى الرسول، فعقدوا عدة معاهدات مع الأمراء ، أشهرها المعاهدة التي عقدها الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل ” ايلياء ” بيت المقدس بعد استسلام المدينة في العام الخامس عشر للهجرة النبوية، ومن شروطها أن لا تخالف النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وأن تكون بموافقة الخليفة أو من ينوب عنه، وأن تكون هناك مصلحة محققة، وأن تكون محددة بوقت معين.
ولن نخوض في مسألة شرعية أو عدم شرعية النظم السياسية الإسلامية، التي تعتبرها الجماعات الإسلامية المسلحة غير شرعية، وكذلك في الإجابة عمن أعطى تلك الجماعات الحق في إصدار فتاوى وأحكام تتعلق بالمسائل التي ذكرناها وبخاصة ” الأمان”، ولكننا نناقش هذه المسألة كون تلك الجماعات أصبحت حاضرة في العديد من الدول، وتسيطر على كثير من المناطق فيها، وهي مسألة بحاجة لتوضيح وبيان، وقد أعطى الفقهاء القدماء والمعاصرون للجماعات والأفراد الحق في إعطاء ” الأمان”.
وقد بدى ذلك واضحاً في التعريف الفقهي لـ” الأمان”: وهو عقد غير لازم، قابل للنّقض بشروطه، وحكمه الجواز مع شرط انتفاء الضّرر – وإن لم يظهر المصلحة فيه على ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، خلافاً للحنفيّة الّذين يشترطون : أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين، ومن الفروق الظّاهرة بين عقد الأمان وعقد الهدنة أنّه لا تجوز الهدنة إلاّ بعقد الإمام أو نائبه، أمّا الأمان فإنّه يجوز من الإمام ومن جماعة من المسلمين ومن آحادهم ولو من امرأة عند جمهور الفقهاء. وقال ابن الماجشون من المالكيّة: إنّ أمان المرأة والعبد والصّبيّ لا يجوز ابتداءً، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء ردّه([10]).
وفي هذا السياق؛ ورداً على سؤال وجه للشيخ ” أبو حفص الموريتاني”([11]) حول إعطاء الجماعات الجهادية عهد “أمان” للمنظمات الدولية، قال فيه:” لا شك أن كثير من المنظمات الدولية الإنسانية، تسعى دائماً للحصول على ” أمان” في المناطق التي يتحركون فيها وتخضع لسيطرة الجماعات الجهادية، ولا بد أن أوضح رأيي في هذه المسألة، رغم أنه ليست لدي صلات تنظيمية بهذه الجماعات، ولكنهم إذا سمعوا رأيي في مسألة معينة وكان الوفاء والقيام بها لا يشكل عبئاً أو ضرراً لهم، أخذوا وعملوا بها”.
وتابع “أبو حفص”؛ “والأهم من ذلك أن هذه المنظمات الدولية، تعتبر منظمات إنسانية تعمل وفق مبدأ ” الحيادية”، فإذا تأكدت ” الجماعة ” أنها منظمات ” محايدة”، وتحمل رسالة إنسانية، فحقيقة الأمر أنها لا تتعرض لتلك المنظمات، بل هناك حاجة لعمل هذه المنظمات، وبخاصة أنه توجد حالات إنسانية لدى الجماعات بحاجة لمساعدة المنظمات الدولية الإنسانية” .. ويحصل أحياناً أن بعض الأطراف – يقصد القوات الدولية – في أفغانستان قامت باستخدام سيارات الصليب الأحمر لأغراض عسكرية، ولا أدري أكان هذا الاستخدام بعلم أو عدم علم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أم لا، ولا أستبعد أن يكون تم تزوير الشارة الدولية، ومثل هذه الحوادث تفقد المنظمات الدولية الإنسانية مصداقيتها عند الجماعات”.
وبيّن أبو حفص الموريتاني، بأنه لو ثبت لدى ” الجماعات ” حيادية المنظمات الدولية الإنسانية بشكل تام، ولا يتسرب منها أخبار ومعلومات عن عناصرها وقياداتها ومواقعها، ولا أية أمور أخرى تضر بها، وأنها تخدم جميع الأشخاص دون تمييز، أظن أنها – أي المنظمات الدولية الإنسانية – لن تواجه أي مشكلة في ظل حاجة ” الجماعات إلى الخدمات والأعمال التي تقوم بها تلك المنظمات.
كما أوضح ” أبو حفص الموريتاني”؛ بأنه لا يمكن وصف المنظمات الدولية الإنسانية بــ ” المحاربة([12])“، و تتمنى الجماعات الجهادية فعلاً أن تجد المنظمات الدولية الإنسانية سمة ” الحيادية ” بشكل مطلق، لأنه تولد لدى بعض الجماعات صورة نمطية من عدم الثقة بسبب ممارسة بعض المنظمات الدولية الإنسانية في الميدان وأثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وبخاصة أن سلوكها أبدى تحيزاً للطرف الآخر المعادي للجماعات، وتصبح هذه المنظمات الإنسانية في مصاف الأعداء.
وفي حال ما أعطت الجماعات الجهادية، بمختلف أطيافها واختلافنا مع طروحاتها ورؤاها، ” أمان” لأي فرد أو منظمة إنسانية سواء كان شفهياً أو مكتوباً فإنها تلتزم به، بحسب أبو حفص.
وقد يُساء استخدام الإشارة التي تدلل على منظمة دولية إنسانية، من قبل مختلف الأطراف المتنازعة سواء الدول أو الجماعات المسلحة، فقد يحصل اختراق استخباراتي لبعض العاملين في المنظمات الدولية، الذين يقومون بنقل المعلومات والأخبار الخاصة بتحركات عناصر وقيادات ومواقع الجماعات الجهادية، وليس بالضرورة بعلم أو بالتنسيق مع إدارة تلك المنظمات، وهذا يساهم في زعزعة الثقة فيها، ويتحمل القائم بالمخالفات بعواقب أعماله.
وقد ضرب ” أبو حفص الموريتاني ” مثالاً على عدم الثقة في المنظمات الدولية، حيث سرد كيفية تعامل مقاتلي حركة طالبان مع سيارات ومعدات وأجهزة المنظمات الدولية الإنسانية، عقب دخول قوات التحالف الدولي إلى أفغانستان، وخروج تلك المنظمات، فقد كان الاتفاق مع حركة طالبان إبان حكمها مع المنظمات الدولية الإنسانية بأن تسلم معداتها وأجهزتها وسياراتها إلى الحركة بعد خروجها من أفغانستان، ومع بدأ المعركة الدولية ضد الحركة، سلمت هذه المعدات والسيارات إلى الحركة بمقتضى الاتفاق بينهما، والطريف في الأمر أن عناصر وقيادات حركة طالبان لم تستخدم تلك المعدات والأجهزة والسيارات لخوفها من وجود أجهزة تحديد المواقع، ولم يقم مسؤولوا الحركة بفحصها حين تسلموها، لأنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية للقيام بعمليات الفحص والتأكد من خلوها من أجهزة التجسس، وإن دل هذا فإنه يدلل على أن الثقة غير متوفرة بهذه المنظمات.
أما الشيخ ” أبو عُمر سندة بوعمامة”، فقد بيّن أن موقف الجماعات الجهادية في الساحل وغرب أفريقيا من منظمة أطباء بلا حدود، لم يتغير وعبر عن ذلك بقوله: ” بخصوص أطباء بلا حدود، كانت لهم تجربة مع الجماعة ولبعضهم معرفة شخصية مع أهم الأمراء، وعملهم محل ترحيب من الكل؛ إن هم التزموا بالشروط التي قدمت لهم”([13]).
الشروط العامة لـ ” الأمان”:
- أخذ موافقة أو تصريح بدخول المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، شفهياً أو مكتوباً، ويقاس على ذلك التأشيرة/ الفيزا التي تمنح للشخص الذي يرغب بزيارة أي دولة.
- إعلام الجماعة بطبيعة النشاطات والتحركات اليومية.
- تقديم كشف بأسماء العاملين في المقرات الطبية الإنسانية.
- عدم القيام بأي من الأعمال التالية: أ. التجسس بالتصوير أو الاستفسار عن أماكن انتشار الجماعة وأسماء العناصر والقيادات. ب. التصوير للأماكن العامة والعسكرية. ج. العمل في مجال التبشير لديانة أخرى. د. عدم التنقل من مكان لآخر دون الحصول على تصريح.
- الحيادية في العمل.
- رفع شارة المنظمة الإنسانية.
وقد بين تنظيم ” الدولة الإسلامية”، موقفه من ” العهد” أو ” الأمان”، من خلال اللقاء الذي أجرته صحيفة النبأ الاسبوعية، مع أمير “هيئة الهجرة”[14]، حيث وضع المعايير في عمل هيئته في التعامل مع غير المسلمين الراغبين في دخول البلاد والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم، إذ أنه لا يسمح لغير المسلمين بدخول الأراضي التي يسيطر عليها ويسميها ” دار الإسلام”، أو الإقامة فيها إلا بعهد أو أمان، وهذا العهد مشروط ومقيّد لمن تسمح حالتهم بإعطائهما له، وتكون الإقامة مشروطة ومحدودة، وبخاصة للذين لا يحملون جنسية البلد التي سيطروا عليها[15].
فيما يسمح التنظيم، لأي مسلم بغض النظر عن الجنسية التي يحملها، دخول البلد والإقامة والتنقل فيها، ولا يفرقون بينه وبين السكان الأصليين المولودين فيه أو المقيمين أصلاً فيه، بل يقدمون له كل التسهيلات اللازمة للإقامة، كونه ” مهاجراً”، ويمنع المسلم من مغادرة البلد التي يسيطرون عليها إلا بتصريح أو عذر، ومن الأعذار المقبولة السفر للعلاج في حال لم يكن متوفراً في البلد، على اعتبار أنه سيغادر إلى ” دار الكفر”، والواجب الشرعي يحتم عليهم منعه، ويسمح للتجار الذين يستوردون البضائع بالسفر والعودة، وفي بعض الحالات الخاصة التي لم يفصح عنها التنظيم، وبموافقة الإمام[16].
وقد ضرب أمير هيئة الهجرة مثالين في التعامل مع غير المسلمين، الأول لشخص قام بزيارة أقاربه أثناء سيطرة التنظيم على مدينة الرقة والموصل، وتجول في البلاد وغادرها بعد الزيارة، والمثال الثاني، لمن يرغب من غير المسلمين في الإقامة في البلد فعليهم دفع الجزية، لأنهم يعيشون بأمان، وواجب حمايتهم على الدولة[17].
الانسحاب من المُدن
حينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على حركة طالبان، قامت الحركة بالانسحاب من المُدن التي تسيطر عليها دون مقاومة وذابت في الأحياء بين الناس وأعادت انتشارها في الجبال، لتنتقل من الدولة إلى الثورة من جديد، وهذا ما فعلته تكراراً حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وكذلك ما فعله تنظيم القاعدة وحركة أنصار الدين وغيرها من الجماعات المسلحة في مالي عند تدخل فرنسا وحلفائها في الساحل.
الانسحاب المنظم من المدن، تكتيك تستخدمه الجماعات الجهادية المنتشرة في العالم، وذلك لإدراكهم التام بأن سيطرتهم على مدينة ما، يحمل في طياته رسالتين، الأولى موجهة للمجاهدين: إما أن تغادروا المُدن، أو تدمر على رؤوسكم، والثانية موجهة لسكان المُدن من عوام المسلمين ومضمونها: كل مدينة يسيطر عليها المجاهدون سوف تتحول إلى دمار، فإن اردتم سلامة مدنكم فلا تسمحوا لهم بالسيطرة عليها.. لكي يبقى راسخاً في أذهان الناس؛ أن سيطرة المجاهدين على أي مدينة تعني أنها ستتحول إلى الدمار والخراب”( [18]).
إمكانية التفاوض مع الجماعات المسلحة
وثيقة القاعدة مع الدولة الموريتانية ” المتاركة ” أنموذجاً
لاحظ الباحث أن هناك حالة من الاتفاق الضمني بين الجماعات الإسلامية المتنوعة – بما فيها المسلحة- والدولة الموريتانية من خلال لقاء العديد من الدعاة وطلبة العلم، والصحفيين والباحثين، وقد تبين بحسب ما ذكره ” أبو حفص الموريتاني”، بأن هناك اتفاق ضمني بين الحكومة الموريتانية والحركات الجهادية، شبيه بمسألة الهُدنة بين الطرفين، ينص على أن لا تقوم الحركات الجهادية بأي نشاط عسكري داخل موريتانيا، وأطلق على ذلك مفهوم ” المُتاركة “، ويعني ذلك عدم القيام بأي نوع من أنواع النشاطات العسكرية داخل بلد ما ( [19])، وهذا يدلل على أن هناك إمكانية للتفاوض والتحدث مع الجماعات الإسلامية المسلحة، الذي يساهم في حال نجاحه إلى حد كبير في إنهاء حالة العنف في البلد الذي يسعى إلى فتح قنوات اتصال تفاوضية، رغم معارضة الدول الكبرى لهذا السلوك على اعتبار أنها لا تفاوض ” الإرهابيين”، ويتعارض ذلك مع سياساتها الاستعمارية في السيطرة والهيمنة على النفوذ والثروة.
ما أشار إليه ” أبو حفص الموريتاني”، تحدثت عنه وثيقة من وثائق أبوت أباد، التي وجدت في المنزل الذي قتل فيه أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وهي رسالة أرسلها بن لادن، إلى عطية الله وأبو يونس الموريتاني، تناولت الإجابة على رسالة زعيم فرع التنظيم في المغرب الإسلامي، أبو مصعب عبد الودود، وموضوعها الهدنة مع ” المرتدين”، وتضمنت أن بن لادن عرض الموضوع على الشيخ محمود – عطية الله الليبي-، وأبو يحي الليبي لكتابة بحث شرعي حول جوازها.
وقد طلب بن لادن أن تتضمن الهدنة النقاط التالية:
- التزام المجاهدين بالامتناع عن القيام بأي نشاطات عسكرية في موريتانيا.
- التزام الحكومة الموريتانية بعدم التعرض لـ” المجاهدين” بأذى في البلد، وعدم تعرضها لطلبة العلم من الداخل أو الخارج بأي سوء.
- إطلاق سراح الأخوة المسجونين كافة.
- التزام الحكومة بعدم انطلاق أي عمل معاد للجماعات الجهادية من أراضيها.
- التزام الحكومة الموريتانية بدفع مبلغ يتراوح ما بين 10-20 مليون يورو سنوياً لتنظيم القاعدة، ما دام العقد سارياً، أو عند تجديده إن انتهت المدة تعويضاً عن الامتناع عن خطف السياح.
- الاتفاق بين الطرفين سري.
- سريان الاتفاق لمدة سنة قابلة للتجديد.
وقد أبدت هذه الوثيقة وما آلت عليه طبيعة العلاقة مع الجمهورية الموريتانية؛ مرونة سياسية واضحة من قبل تنظيم القاعدة وتعتبر مرجعية وسابقة في هذا المجال، تبعها وثيقة أزواد، وتعتبر حالة متقدمة من تعامل الحركات الجهادية مع الحركات الوطنية، حيث قامت الجماعات الإسلامية المسلحة بعمل وثيقة اشتهرت باسم ” وثيقة أزواد”، تنظم العلاقة مع الجماعات والحركات والقيادات القبلية بمختلف أعراقها، نجحت من خلالها هذه الجماعات بتحييد صراعها مع تلك الأطراف والتفرغ لبناء جبهة عريضة لمواجهة الحكومة المركزية، وهذه الوثيقة تعد بحق انموذجاً لتطور الفكر السياسي وفقه الواقع للجماعات السلفية الجهادية في التعامل مع الآخر، وهي بحاجة إلى دراسة معمقة للوقوف على تلك التجربة الفريدة([20]).
المعاهد والمحاضر الدينية في موريتانيا:
أثار قرار السلطات الموريتانية بإغلاق المدارس والمعاهد القرآنية في تشرين الأول عام 2016 ردود أفعال العلماء والدعاة ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد، بذريعة أن بعضها غير مرخص، والبعض الآخر يتبع لجماعة الإخوان المسلمين( [21] ).
وما زالت المدارس التقليدية والتي تسمى ” المحاضر” فاعلة في النظام التعليمي الشعبي في موريتانيا، وهي تُعنى بتدريس القرآن الكريم وعلوم الفقه واللغة العربية والمنطق، وفق مناهج وطرق طوّرها مشايخ وأساتذة هذه المدارس الأهلية( [22] ).
ومن بين المعاهد والمحاضر الدينية في موريتانيا، مركز تكوين العُلماء الذي يشرف عليه الشيخ محمد الحسن ولد الددو، ومعهد الدراسات الإسلامية، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والجامعة الإسلامية – العيون.
المؤسسات الدينية في مالي
المجلس الإسلامي الأعلى: يرأسه الشيخ محمود ديكو، ويعتبر من المؤسسات الدينية شبه الرسمية، ويحظى على علاقات جيدة مع دول الخليج وبخاصة السعودية، التي تعد من أكبر مموليه.
اتحاد علماء إفريقيا: منظمة غير حكومية، يضم نخبة من علماء إفريقيا في جنوب الصحراء، بحيث يكون مرجعية علمية فاعلة في المجتمعات الإفريقية، تعزز دور العلماء والدعاة في قيادة المجتمع بشرائحه وطبقاته؛ وتضبط الفتوى، وتتفاعل مع القضايا والأحداث العامة في القارة، وتعبر عن مسلمي إفريقيا في المحافل المحلية والإقليمية والدولية( [23]).
منظمة الفاروق: وهي منظمة محلية غير حكومية خيرية، تعمل في نطاق التعاون المبرم مع الحكومة في مجالات الخدمة الإنسانية: التعليم، الدعوة، الصحة، الإغاثة، وقد انبثقت عن المنتدى الإسلامي، وتم ترخيصها تحت هذا المسمى عام 2006( [24] ) .
وزارة الشؤون الدينية
المعهد الإسلامي
مجلس علماء وكُتاب شمال مالي http://cuen-mali.blogspot.com/
ولا بد إلى الإشارة؛ بأن التعليم الديني ما زال حاضراً بقوة في المساجد على شكل حلقات التدريس للقرآن والحديث والفقه واللغة العربية، يقوم به أئمة المساجد وطلبة العلم، وبخاصة أولئك الذين درسوا الشريعة في الدول العربية والإسلامية، وهي شبيهة بـ ” المحاضر” الموريتانية.
التسويات والمفاوضات:
تميز موقف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمود ديكو، واتحاد عُلماء إفريقيا، بضرورة إدماج الجماعات الإسلامية المسلحة في مالي بالحل النهائي للأزمة، وقد ركزوا على إدماج الجماعات المحلية فقط وإخراج الأشخاص المشاركين في القتال من البلدان الأخرى – الأجانب- من البلاد.
نجحت فرنسا في تدويل القضية المالية، فبعد إعلان الرئيس الفرنسي السابق، ” فرانسوا هولاند” بالقضاء على ما أسماه ” الجنين الإرهابي” عقب سيطرة الجماعات المسلحة على الشمال المالي، عام 2012م، فقد وسعت فرنسا جهودها لمحاربة الجماعات المسلحة في مالي، بالقيام بما يلي: 1- تأسيس جيش الساحل. 2- تأسيس مجموعة 5، لإشراك عدد كبير من الدول في الحرب. 3- الحصول على تفويض أممي وفق الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. 4- توزيع مسؤولية النفقات المالية على المجتمع الدولي، بما فيها السعودية والإمارات.
وتعتبر الجماعات المسلحة الخطوات الفرنسية آنفة الذكر، تعكس مدى الفشل الذريع الذي منيت به فرنسا من خلال عمليتها السابقة ” سرفال”، و”برخان”.
مستقبل المصالحة في إقليم أزواد:
يبدو أن هناك عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة لتنامي حالة من شعور عدم التفاؤل بديمومة المصالحة الوطنية في إقليم أزواد التي تسير في بطء شديد، ومنها: التنوع الإثني، والتدخل الإقليمي والاجنبي في الإقليم، ومحدودية تطبيق اتفاقيات المصالحة السابقة، واتهام متبادل لسوء النوايا نحو المصالحة الوطنية، وكذلك تواجد الجماعات الإسلامية المسلحة، التي ترفض الدخول في مفاوضات من جانبها، وكذلك من جانب المجتمع المحلي والدولي لأنها مصنفة إرهابية؛ هذه الأسباب وغيرها ولدت حالة من عدم الثقة لدى كافة الأطراف المتنازعة في الإقليم وبخاصة من مكونات المجتمع الأزوادي، وليس من طرف النظام السياسي في مالي، بأن حل القضية الأزوادية معقد وصعب وأن المنطقة من الممكن أن تشتعل من جديد في اي لحظة.
إذ يتوقع الباحث في شؤون الساحل وغرب الصحراء، محمد أبو المعالي، فشل اتفاقيات السلام التي عقدت في الجزائر، لان مخرجاتها في اعطاء حكم ذاتي لأهالي أزواد لم يتم تطبيقها، كما جرت العادة في اتفاقيات سابقة، وتعتبر بعض قيادات الصف الثاني، بأنها أرغمت على التوقيع بضغط من السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي؛ عبر تصنيف الحركات الرافضة للتوقيع بـ ” الإرهابية”، وبالتالي من الممكن أن يشكل ذلك عاملا سلبياً في استمرار هذه المفاوضات ونجاحها[25].
أوضح ولد سيدات بأن شكل الحكم مستقبلاً في الإقليم، ان كل ولاية تمثل فدرالية مستقلة في القرارات تتبع المركز في العاصمة، يكون الحاكم أو الوالي منتخباً وليس معينا من العسكريين، لكي يدعم الشرعية[26].
يعتقد أحمد بيبي، بأن حل القضية الازوادية يواجه تحديات وصعوبات وتحولات معقدة ليس من السهل حلها، لوجود تضارب في المصالح بين مكونات الشعب الأزوادي من ناحية، وبين دول الإقليم والدول الأجنبية من ناحية أخرى، وأن اتفاقية الجزائر اتت بمجموع ما جاءت به الاتفاقيات السابقة، ما عدا بعض الاصلاحات الإدارية وبعض التغيرات الدستورية، وهي لا تعالج المطالب بالاستقلال ولا تحكيم الشريعة، ولا المطالب الانفصال، ولذلك الحل جزئي وليس شامل، وما زالت الاسباب للأزمة قائمة، فلا يمكن استبعاد مطالب الجماعات التي تسمى ” الإرهابية ” على سبيل المثال، ولا يمكن انكار وجودهم، لذلك فإن الاتفاقية ممكن أن تستمر لفترة محددة وليست دائمة[27].
يرجح أمير الصحراء، يحي أبو الهمام، بأن السيناريو المحتمل لمستقبل إقليم أزواد، هو إيجاد كيان أو نظام سياسي تبعيته للغرب، بحيث يضمن من خلال هذه التبعية موطئ قدم في هذه المنطقة عبر اتفاقيات طويلة الأمد، ويشكك في دعاوى فرنسا بان هدفها الحفاظ على وحدة التراب المالي، لانها تدعم قومية على حساب قوميات أخرى، وفشلت في خلق كيان قومي للطوارق في المنطقة[28].
ويرجح ولد سيدات فشل المفاوضات واتفاقيات السلام إلى غياب النظام والأمن والتنمية هي اهم عوامل فشل المفاوضات من جهة وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة من جهة ثانية، مقابل تعزيز التدخل الأجنبي[29].
وبدى عضو المكتب السياسي ” للبلاتفورم “، محمد ولد يحي الحسني متفائلاً ودبلوماسياً في إجابته عما سبق من أراء بعض القيادات المتشائمة، بتأكيده بأن الاتفاق الأخير رغم المعوقات، في تقدم بخطى ثابتة وبهدوء، ورغم وجود عدم ثقة في ماكنة تحريك الاتفاق، والمستقبل خاضع لردود افعال الأطراف واحترام بعضه البعض، وجدية المجتمع الدولي في تحقيقه وتثبيته، الاتفاقات السابقة لم تفشل بل حققت جوانباً منها بنسب منخفضة[30].
وقد اختلفت وجهة نظر محمد ولد يحي الحسني، في مقابلة الباحث له بعد حوالي السنتين في الاتفاق، حيث قال بأن الاتفاق يسير ببطء شديد، ولم يتم تنفيذ أجزاء كبيرة منه، وأن الحكومة المالية تمارس سياسة كسب الوقت، من خلال اقناعها للاطراف المفاوضة بوعودها الزائفة، كمن يسير وراء السراب، ومن وعودها بإدماج عناصر الحركات المسلحة في القوات المسلحة، والوظائف الحكومية، ولكنها لم تف بوعودها[31] .
لعل التقرير الصادر عن المبعوث الأممي لمالي، محمد صالح النظيف والمتعلق بتطورات الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لمجلس الأمن في جلسته رقم 7719 المنعقدة بتاريخ 16 حزيران / يونيو 2016، تدلل على الانتقاد الشديد والشعور أيضاً بحالة من عدم الرضا على التزام أطراف النزاع في مالي ببنود الاتفاق الموقع منذ حوالي العام، والتحذير من عملية البطء غير المبررة في تنفيذه، التي من الممكن أن يعرض عملية المصالحة للخطر، بالاضافة إلى التأخر في إنشاء بعض الإدارات المؤقتة لمزاولة أعمالها[32].
واشار المبعوث الأممي في تقريره إلى تدهور الوضع الأمني الذي شهدته مالي، في الفترة الواقعة ما بين شباط إلى أيار / 2016، والتي لقي فيها 19 عنصراً من قوات حفظ السلام مصرعهم على يد الجماعات المسلحة، وعزى سبب الخلل في وقوع هذه الخسائر إلى ضعف التدريب والتجهيز لدى قوات حفظ السلام الأممية[33].
ومن الجوانب الإيجابية التي ذكرها النظيف في تقريره أمام مجلس الأمن، أن الاطراف ملتزمة بشكل صارم في وقف إطلاق النار، والجهود التي تبذلها الحكومة المالية في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي قوي من أجل تنفيذ الاتفاق، وبخاصة إنشاء المجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن الخاضع لسلطة رئيس الوزراء، وتطوير المؤسسة العسكرية ومواقع الإيواء، وتأسيس لجان أخرى تعمل على الإشراف على نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، واللذان يشملان إدماج المقاتلين السابقين وإدارة التطرف العنيف[34].
من جانبه رد موفد الجمهورية المالية للامم المتحدة، مودييو كيتا، رئيس الوزراء المالي، في محاولة منه للدفاع عن حكومته جراء انتقادات المبعوث الأممي وفريقه في مالي لأداء الحكومة تجاه المصالحة والاتفاق، بقوله: ” سوف نركز من جانبنا على مسألتين رئيسيتين ناشئتين عن تقرير الأمين العام، وهما 1-) الإصلاحات السياسية والمؤسسية و 2-) مسائل الدفاع والأمن”. وعرج على التعديلات القانونية التي تمهد الطريق لإنشاء السلطات المؤقتة[35].
وحول انجازات الحكومة المالية المتعلقة بالمصالحة، فإن رئيس الوزراء المالي علل سبب البطء في تنفيذ بنود الاتفاق من الجانب الحكومي إلى الديمقراطية، بمعنى أن التراتبية في المصادقة على القوانين تحتاج إلى وقت وبخاصة أن هناك معارضة لبعض القوانين والتي لجأت بعض الجهات إلى المحاكم المختصة ونظرت بها، وهذا ما أعاق عملية سن القوانين والتشريعات، كما أشار إلى الاجتماعات المتواصلة مع الأطراف الموقعة لاتفاقية المصالحة، والاتفاق على إنشاء إلية التنسيق التشغيلي في المناطق وتعيين السلطات المؤقتة، وإعادة نشر الإدارة وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذلك القيام بدوريات عسكرية وأمنية مشتركة[36].
وطالب رئيس الوفد المالي، بتقديم الدعم للمبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، لأن ” الإرهاب” يشكل تهديداً لكل الدول[37].
مشاريع مقترحة للتعاون مع المجتمع المحلي في تمبكتو وأطرافها:
اقترح عمدة تودينو محمد الحاج طاهر، ووجهاء من مدينة تمبكتو مشروع فتح عيادة وتقديم مساعدات طبية انسانية بالتعاون مع بعض المحليين.
فتح عيادة في
المناطق التي تحيط في تمبكتو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
[1] ” جبهة تحرير ماسينا” أول حركة جهادية تنتمي لعرق ” الفلان”، ويتزعمها ” أمادو كوفا”، وتستمد الجبهة جذورها الفكرية من الدعوة السلفية التي أطلقها ابن المنطقة “الشيخ عثمان فودي” في العام 1795، وتعد مدينة تننكو في الوسط الغربي لجمهوية مالي، أحد أكبر معاقلهم، وتعتبر أحد الجماعات التي دخلت في التحالف الجديد الذي ضم: جماعة أنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمرابطون، وجماعة المجاهدين، وجبهة تحرير ماسينا، وأفضى هذا التحالف إلى تأسيس ” جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في الساحل وغرب إفريقيا، بزعامة ” إياد أغ غالي”، أنظر: . https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/5/7/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
([2]) مجلة قراءات إفريقية. قضية مالي ومستقبل المنطقة، العدد 16، ربيع الآخر – جمادي الأخر/ 1434هـ، نيسان- حزيران 2014م، ص ص 2-3.
([3]) البعض يطلق عليها الأزمة الأزوادية، لأنها تنطلق دائماً من الشمال وتحديداً من إقليم أزواد، ولأن شعب هذا الإقليم ما زال يتهم الحكومة المركزية في الجنوب بأنها تقصيه وتهمشه ولا تقوم بالمشاريع التنموية على أكمل وجه، ويسعى قاطنوا الإقليم بمختلف مكوناته العرقية إلى الحصول على حكم ذاتي، أو لا مركزية لإدارة الإقليم.
([4]) محمد محمود أبو المعالي. ” التنافس بين القاعدة والدولة في الساحل والصحراء”، مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم ناشرون، كانون الثاني/ يناير 2017، ص ص 197 – 244.
([5]) بوابة افريقيا الإخبارية، تاريخ الدخول 17 نيسان 2018، الساعة 7:35 صباحاً، http://www.afrigatenews.net/content/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%E2%80%98%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%E2%80%99-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%9F، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مؤسسة الزلاقة للإنتاج الإعلامي، موقع التلغرام، https://t.me/Az_Zallaqa1 ، بيان الإعلان عن تشكيل الجماعة، آذار/ مارس 2017.
([6]) الحركات والجماعات المسلحة التي تنتمي للتيار الجهادي
والتي سيطرت على شمال مالي منذ عام 2012م، فمنها:
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، معظم قياداتها وأعضائها من الجزائر،
وموريتانيا، والصحراء الغربية، وتونس، وليبيا.
حركة أنصار الدين: قائدها الطارقي إياد أغ غالي، كان عضوا في جماعة التبليغ، ولم يسبق له في كل التمرُّدات التي شارك فيها مطلب إسلامي واحد. عُيِّن قنصلا عامًّا لمالي في جدَّة ولبس لبوس السلفيَّة قبل أن تطرده السلطات السعوديَّة؛ فعاد إلى مالي وأسَّس الحركة. أغلبُ أعضائها من طوارق مالي وبخاصَّة الإيفوغاس الذين وجدوا فيها حركة شعبيَّة سلفيَّة جهاديَّة.
وقد أعلنت عن نفسها في عام 2015م، غالبيَّة أعضائها من سكَّان جنوب مالي وبخاصَّة الماندنغ/البمباره، وهم ممَّن قاتلوا في أنصار الدين شمال مالي وكانت مجموعتهم تُعرَف بــ”كتيبة خالد بن الوليد”. تنشط على حدود مالي وساحل العاج وغينينا كوناكري.
حركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا: (MUJAO)، مُعظمُ عناصرها من عرب موريتانيا، والجزائر ، والصحراء الغربية المقيمين في الجزائر، وأفراد من عرب مالي. و يرى بعض الباحثين أنَّ هذه الحركة إنَّما هي النسخة العربيَّة لحركة أنصار الدين الطارقيَّة. الأولى حركة جهاديَّة سلفيَّة عربيَّة، والأخرى حركة جهاديَّة سلفيَّة طارقيَّة. ثمَّ تمكَّنوا من استقطاب بعض المجموعات الإفريقيَّة. وفي يوليو2014م أعلنت ولاءها لــ” داعش”.
جبهة تحرير ماسينا: تسعى في إحياء قوميَّة فولانيَّة إسلاميَّة تنفصل عن بماكو، وتنهَج منهج الدولة الإسلاميَّة الفولانيَّة (دولة دِينا) التي أقامها أحمد لبُّو في إقليم ماسينا في القرن التاسع عشر الميلادي( 1818- 1862م)، تُطبِّق الشريعة الإسلاميَّة وتمنع القوانين الوضعيَّة. غالبيَّة أعضاء هذه الحركة من الفلانيين الذين كانوا يُقاتِلون في شمال مالي، وقد عُرِفت مجموعتهم بـــ” كتيبة ماسينا”.أعلنت عن تأسيسها في أبريل 2015م بقيادة أحمد كُوفا، نسبة إلى قرية كُفَّ بمنطقة موبتي. وهي على علاقة وثيقة بالقاعدة وحركة أنصار الدين،
([7]) مجلة قراءات أفريقية، مرجع سابق، العدد 16، ص3.
([8]) محمد يحي الحسني. مرجع سابق.
([9] ) يعرف القانون الدولي الإنساني، ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي يتكون من أحكام عرفية واتفاقية تستهدف، في حالة النزاع المسلح، حماية فئات محددة من الأشخاص والممتلكات وتحدد سلوك أطراف النزاع في استعمال وسائل القتال وأساليبه، للمزيد أنظر: د.عامر الزمالي.” مقالة في القانون الدولي الإنساني والإسلام، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة، آب/ أغسطس 2010.
[10] (الموسوعة الفقهية. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1404هـ – 1983م، الجزء السادس، ص ص 233- 235.
([11]) أبو حفص الموريتاني ( محفوظ بن الوالد). لقاء شخصي في منزله في العاصمة الموريتانية “نواكشوط”، بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2018.
([12]) المحاربة، بمعنى المقاتلة التي يمكن قتالها وإعلان الحرب عليها واستهداف مقراتها والعاملين فيها.
([13]) أبو عمر سندة بوعمامة. حوار خاص عبر موقع التواصل الاجتماعي ” التلغرام”، حيث تعذر لقائه شخصياً لأسباب أمنية من ناحية، ولأنه يقيم بالقرب من الحدود الموريتانية – المالية في الصحراء، أجري الحوار بتاريخ 24 آذار / مارس 2018، والشروط التي يقصدها هي: إعلام الجماعة التي تسيطر على مدينة ما بطبيعة نشاطات المنظمة، والتنسيق معها، عدم القيام بأعمال تتعلق بالتجسس، أو تقديم معلومات عن مواقع وعناصر وقيادات الجماعات، استخدام إشارة تدلل على سيارات ومواقع وأفراد المنظمة، عدم القيام بأعمال تتعلق بنشر الدين المسيحي ( التبشير)، عدم استخدام سيارات ومواقع المنظمة لأغراض عسكرية من قبل الطرف الآخر.
[14] هيئة الهجرة: تُعنى باستقبال المُهاجرين إلى ” الدولة الإسلامية”، وتوفير ما يلزم للهيئات والدواوين، وإدارة حركة السلع والأفراد من المسلمين وغيرهم، عبر ضبط الحدود والمعابر.
[15] أمير هيئة الهجرة في تنظيم الدولة الإسلامية. حوار صحيفة النبأ الاسبوعية، الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي، العدد 49، تاريخ 5 محرم، 1438 هــ، ص 9.
[16] مرجع سابق. صحيفة النبأ، العدد 49، ص 9.
[17] مرجع سابق. صحيفة النبأ، العدد 49، ص 9.
([18]) “أبو المُنذر الشنقيطي”. تبيين المقال في مشروعية التحرّف للقتال”، مؤسسة نُخبة الفكر، رجب 1437هـ، أيار/ مايو 2006م، ص 3.
([19]) أبو حفص الموريتاني ( محفوظ بن الوالد). لقاء شخصي في منزله في العاصمة الموريتانية “نواكشوط”، بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2018.
([20]) توجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي الجهادي بأزواد. اشتهرت باسم ” وثيقة أزواد“، صادرة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، السبت، 02 رمضان، 1433 هـ الموافق :20/07/2012م، http://islamion.com/news/show/14054
[21] موريتانيا 13. موقع الكتروني شامل، http://www.mauritania13.com/node/2452 . العربية نت. https://bit.ly/2JZqI8e .
[22] رصيف 22. “موسم الهجرة إلى موريتانيا لدراسة العربية”، https://bit.ly/2vnzBFg .
([23]) اتحاد علماء إفريقيا. www.africanulama.org
([24]) منظمة الفاروق. http://www.alfaroukong.com/index.php/ar/
([25]) محمد محمود أبو المعالي. مقابلة شخصية، نواكشوط، 15/ 4/ 2016.
([26]) سيدي إبراهيم ولد سيدات. أحد قيادات تنسيقية المعارضة (CMA)، ويمثل الحركة الأزوادية العربية، مقابلة شخصية، في العاصمة المالية ” باماكو”، بتاريخ18/ 4/ 2016، ويقيم حالياً في باماكو رغم انه من قيادات المعارضة، معللاً ذلك بأن لديه وبقية المفاوضين حماية إقليمية ودولية بضمان سلامتهم.
([27]) أحمد بيبي. عضو مجلس النواب في جمهورية مالي، مقابلة شخصية في منزل الزعيم الطارقي الشيخ محمد أغ انتال، باماكو، 18/4/ 2016.
([28] ) مقابلة مع أمير الصحراء، يحي أبو الهمام، مرجع سابق.
([29]) إبراهيم ولد سيدات. مرجع سابق.
([30] ) محمد يحي ولد الحسني. عضو المكتب السياسي للقاعدة الشعبية العريضة ( Platform)، مقابلة شخصية، تمبكتو، إقليم أزواد، 20/ 4/ 2016.
([31]) محمد يحي ولد الحسني، مقابلة شخصية، تمبكتو، الخميس الموافق 8 آذار/ مارس 2018.
([32]) محضر مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجلسة رقم 7719، تاريخ 16 حزيران/ يونيو 2016، حول الحالة في مالي، http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7719&referer=http://www.un.org/ar/sc/documents/search.shtml&Lang=A
([33]) محضر مجلس الأمن، الجلسة رقم 7719، مرجع سابق، وانظر: محلق البيانات الصادرة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين.
[34] محضر مجلس الأمن. الجلسة رقم 7719، مرجع سابق.
[35] محضر مجلس الأمن. الجلسة 7719. مرجع سابق.
[36] محضر مجلس الأمن. الجلسة 7719. مرجع سابق.
[37] محضر مجلس الأمن. الجلسة 7719. مرجع سابق.