محمد السالك ولد إبراهيم
تسعى القوى الإقليمية والدولية المختلفة لوضع يدها على منطقة الساحل الإفريقي بالغة الأهمية الإستراتيجية من أجل أن تكون لها
الكلمة الفصل في تحديد مستقبل استقرار المنطقة في السنوات العشر القادمة فضلا عن تأمين السيطرة على الطريق الغربي للنفط و على المواقع الجديدة لاحتياطيات الطاقة المكتشفة مؤخرا في المنطقة.
لكن، هل ستتحول المواجهة – التي اتسمت حتى الآن بالكر و الفر – بين موريتانيا و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى حرب شاملة مفتوحة، على ضوء التطورات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة بعد العمليات] [ التي قام بها الجيش الموريتاني ضد معسكرات للقاعدة داخل أراضي مالي المجاورة، تلك الدولة التي استطاعت مؤخرا مجموعات مسلحة من الحركة الوطنية لتحرير آزاواد و حركة أنصار الدين أن تسيطر على شمالها و تعلن فيه عن قيام إمارة إسلامية؟ هل استندت الحكومة الموريتانية إلى إستراتيجية محكمة في تلك المواجهة؟ أم أن قرارها كان مجرد ردة فعل عفوية أو تكتيكا غير محسوب؟ ثم، هل تمتلك الدولة الموريتانية – و هي تحتفل بالذكرى الثانية و الخمسين للإستقلال- إمكانيات و وسائل حقيقية لضمان كسب رهان المواجهة المحتملة مع القاعدة؟ أم سيقتصر دور موريتانيا فقط على إشعال فتيل الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل من أجل تدويل الملف و تبرير تدخل عسكري دولي كما حدث في أفغانستان قبل عشر سنوات؟
هل تنطلق المواجهة المحتملة مع القاعدة و أخواتها بعد ما يكفي من التخطيط و الاستعداد لتعكس طفرة في الطموح السياسي ذي طابع إمبراطوري، يحن لاستعادة السيطرة على براري الساحل الإفريقي على طريقة “نابليون”؟ و كيف أثرت و تؤثر تعقيدات الجغرافيا السياسية للمنطقة إقليميا ومحليا على تأويل و تسويق تلك المواجهة من الناحيتين السياسية و الإعلامية في الداخل و الخارج؟ هل يمثل تدخل الجيش الموريتاني – و لو بشكل استباقي محدود- ضد بؤر القاعدة في شمال مالي، حربا في المكان الخطأ؟ أم هي في الأساس حرب بالوكالة عن فرنسا التي ما زالت القاعدة تحتجز رهائنها حتى الآن؟ ما الذي ستكسبه موريتانيا من مواجهة محتملة؟ أم ستكون هي الخاسر الأكبر؟ و ما هي التداعيات و المخاطر و الانعكاسات المستقبلية لهذا الوضع على أمن واستقرار موريتانيا و منطقة الساحل عموما؟
موريتانيا: بوابة الساحل الخطرة
ظلت الدولة الموريتانية، منذ فجر الاستقلال، تبحث عن ذاتها متأرجحة بين عملية بناء وطني داخلي بالغة التعقيد، من جهة، و سعي دؤوب لإيجاد صيغ ملائمة لمقتضيات التعامل مع هاجس التحدي الدولي و الإقليمي الساعي دائما للتدخل في شؤون البلد. و لعل موريتانيا باتت أكثر دول المنطقة تأثرا بتقلبات موازين العلاقات الدولية نظرا لطبيعة موقعها الجغرافي السياسي الإستراتيجي المتميز] [ تبعا لتحولاتها الجيوسياسية التاريخية منذ موريتانيا الرومانية القديمة، مرورا بمرحلة الأمبراطورية الصنهاجية و دولة المرابطين مدة طويلة من الزمن، لتتحول في لحظة معينة إلى مجرد “فراغ” تسيره الإدارة الاستعمارية للتحكم في مستعمراتها في الشمال والغرب الإفريقي، ثم لتكون بعد الإستقلال “همزة وصل” بين غرب و شمال مستعمرات إفريقيا الفرنسية، قبل أن تصبح البوابة الخطرة لمنطقة الساحل الأفريقي التي تمور حاليا بالعنف و الاضطرابات المختلفة.
و رغم الماضي الدولي المشرق لبلاد شنقيط، التي كانت فاعلا دوليا هاما و قوة إقليمية يحسب لها حسابها من خلال الدور الجيوستراتيجي المحوري الذي لعبته إمبراطوريات صنهاجة و دولة المرابطين ونفوذهما الأطلسي و المتوسطي والإفريقي، فقد تحولت موريتانيا فيما بعد إلى مجرد مفعول به في مضمار العلاقات الدولية. و قد بدأ ذلك التحول الإستراتيجي النازل بعد أن وقعت موريتانيا في نطاق النفوذ الفرنسي بموجب المعاهدة العامة لمؤتمر برلين سنة 1885، التي قررت تقاسم القارة الإفريقية بين القوى الدولية العظمى المهيمنة آنذاك على المشهد الدولي.
و على مدى أكثر من قرن من تاريخ موريتانيا الحديث، أي منذ بداية الحقبة الاستعمارية سنة 1899 إلى هذا اليوم، ظل المعطى الخارجي أو البعد الدولي لا يتوقف عن لعب دور حاسم في رسم و تحريك حيثيات الواقع الداخلي لهذه البلاد. حيث تكشف غالبا حفريات السياسة الداخلية الموريتانية عن وجود ترسبات هامة لآثار سياسة خارجية ما، سواء كانت اختيارية أم اضطرارية.
في البدء، قررت السلطات الاستعمارية الفرنسية سنة 1899 إنشاء ما يسمى بموريتانيا الغربية لدواعي جيوستراتيجية قصد اختبار قدراتها في فن إدارة و تسيير الفراغ] [ على حد تعبير الضابط العسكري و الكاتب الفرنسي المخضرم ” أرنست بيشاري” (1883- 1914). و قد كان الهدف الإستراتيجي لفرنسا حينئذ هو مراقبة المنطقة الوسطى السائبة الواقعة ما بين مستعمراتها في كل من إفريقيا الشمالية العربية وإفريقيا الغربية الفرنسية أو السودان الفرنسي. و فيما بعد، تحولت موريتانيا سنة 1904 إلى إقليم مدني، ليتم ربطها -لاحقا- بباقي مستعمرات إفريقيا الغربية الفرنسية سنة 1920.
أما مشروع موريتانيا المستقلة، و إن ساندته بعض النخب الوطنية، فإنه كان يستجيب لاعتبارات جيوستراتيجية تخدم المصالح الفرنسية قبل كل شيء. فقد وضع ذلك المشروع أساسا من أجل منافسة مشروع توسعي آخر، نادى به الزعيم التاريخي لحزب الاستقلال المغربي المرحوم علال الفاسي، وكان يعبر بوضوح آنذاك عن المطامع الترابية للدولة المغربية في موريتانيا. كما كان يهدف إلى إقامة حيز مغربي كبير يمتد من مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة “اندر” على الساحل الأطلسي في السنغال، التي أعاد الفرنسيون تسميتها بـ “سانت لويس” و من ثم إلى مدينة تومبوكتو في الشمال المالي. و ضمن ذلك السياق الدولي التنافسي الحاد، لم تكن فرنسا لتسمح حينئذ بإنشاء موريتانيا مستقلة خشية أن تشكل قاعدة خلفية و ملاذا آمنا للمقاومة الجزائرية النشطة ضد المستعمر الفرنسي و مصالحه في تلك الحقبة.
وعند الإعلان عن استقلالها سنة 1960، بدأت موريتانيا تواجه مبكرا مشاكل جمة على الصعيد الدولي. فكان أن رفض أول طلب لانضمامها إلى الأمم المتحدة جراء استخدام حق “الفيتو” من طرف الإتحاد السوفياتي في ديسمبر 1960. و هكذا لم تقبل عضوية موريتانيا في المنتدى الأممي إلا بعد ذلك ، حيث جرت في إطار عملية “مساومة سياسية” قبل من خلالها الاتحاد السوفياتي الامتناع عن التصويت بخصوص انضمام موريتانيا مقابل حصول جمهورية منغوليا على عضوية الأمم المتحدة.
لقد ولدت موريتانيا من رحم تلك الصدمة الأولى و قد ظل تطورها “الدولتي” على الدوام بالغ التأثر بتذبذب ميزان العلاقات الدولية و بالثقل الساحق للمعطيات “الجيوسياسية” الخاصة بها و بالمنطقة عموما خلال الاثنتين و خمسين سنة الماضية من الاستقلال هي عمر الدولة الوطنية في موريتانيا.
من المهادنة إلى المواجهة
بعد تنامي الخطر المحدق لتنظيم القاعدة و أخواتها في الساحل الإفريقي، على مدى السنوات القليلة الماضية، حسمت الحكومة الموريتانية الحالية خياراتها] [ في المواجهة العسكرية المحدودة من خلال أسلوب الضربات الإستباقية. لكن، ما هو تقييم تلك الخيارات من الناحية الإستراتيجية؟ و ما مدى حظوظها في النجاح و الفشل؟
إذا لم تكن العمليات التي قام بها الجيش الموريتاني مؤخرا ضد القاعدة داخل الأراضي المالية، تندرج في إطار سيناريو سياسي-عسكري دولي على طريقة عمليات الـ “كلاديو” أو ] Stay-Behind[ ، يتم تدبيره بعناية و سرية لخلط الأوراق و لتغيير الأولويات تنفيذا لأجندات داخلية و/أو خارجية لجعل موريتانيا تُقحم في تصفية حسابات ذات طابع إقليمي صرف لا علاقة لها بالحرب على الإرهاب، فإن مما لا شك فيه بأن الجماعة السلفية للدعوة و القتال (GSPC)- التي تحولت في سبتمبر/ أيلول 2006 إلى فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (BAQMI) بعد إعلان ولائها لتنظيم القاعدة الأم – قد نجحت تماما في زرع خلايا نشطة من الجهاديين يتمتعون بقدرات تسليحية و لوجستية نوعية تمكنهم من فتح جبهة جديدة في موريتانيا رغم وجود أعضاء بارزين من التنظيم المسمى بـ “أنصار الله المرابطون” في المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات، و هو التنظيم الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه بات يمثل الفرع الموريتاني للقاعدة. وقد تعززت تلك القدرات التسليحية و اللوجستية و تضاعفت بعد انفجار الأوضاع الأمنية في ليبيا و تسرب السلاح و المسلحين منها نحو الشمال المالي و تركزهما خاصة في إقليم آزاواد.
فهل تشهد صحراء الساحل الإفريقي- تلك المنطقة المسحوقة إيكولوجيا] [ واقتصاديا و المهجورة سكانيا – طورا جديدا من تحولاتها اللامتناهية عبر الزمن؟ فبعد أن عاشت في الماضي فتوحات المرابطين الأوائل وإشعاعهم الثقافي و الروحي الأطلسي والمتوسطي، تحولت منذ سنوات إلى مسرح كبير للإرهاب و لأعمال العنف المختلفة وكذا لأنشطة الرصد والعمليات الخاصة للاستخبارات الدولية في منطقتي المغرب العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء. و ها هي هذه المنطقة تصبح من جديد ميدانا للكر و الفر يأوي مخيمات تجميع و تدريب عناصر الجهاديين قبل إرسالهم إلى الجبهات في الشيشان و العراق و باكستان و الصومال و كذا لتنفيذ عمليات نوعية مختارة من قبل تنظيم القاعدة ضد أهداف تكتيكية أو استراتيجية في موريتانيا و دول المنطقة و ربما في بعض دول أوروبا كذلك، كما تشير توقعات التقارير الدولية. فلا غرو إذن أن تسعى القوى الإقليمية والدولية المختلفة لوضع يدها على منطقة الساحل الإفريقي الإستراتيجية، التي ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد مستقبل استقرار المنطقة في السنوات العشر القادمة و تأمين ضمان السيطرة على الطريق الغربي للنفط و على المواقع الجديدة لاحتياطيات الطاقة المكتشفة مؤخرا في المنطقة.
لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ أن هاجم مهربون مغمورون مجموعة من المشاركين في سباق داكار للسيارات سنة 1999، أو عندما ورد اسم المجموعة السلفية للدعوة و القتال و زعيمها “مختار بلمختار”، المعروف سابقا بـ “خالد أبو العباس” و الملقب “بلعور” ضمن تقارير للإستخبارات الفرنسية و لوكالة المخابرات المركزية إثر إلغاء مراحل “الرالي” في النيجر سنة 2000، ليأتي بعد ذلك اختطاف 32 من السياح الألمان والنمساويين في الجزائر، على يد عمارة السيفي الملقب “عبد الرزاق المظلي” في شباط/فبراير2003، و كذلك عندما ألغيت المرحلتان العاشرة و الحادية عشر من “رالي داكار” بين مدينة “النعمة” شرق موريتانيا و “بوبوـ ديولاسو” في بوركينا فاسو عبر مدينة “موبتي” بمالي في كانون الثاني/ يناير 2004 تحت تهديد تنظيمات إرهابية كانت نشطة في منطقة الحدود بين الجزائر وموريتانيا ومالي. ولكن، يبدو أن نشر بلاغ نسب آنذاك للزرقاوي – الذي كان حينها زعيما للفرع العراقي من مجرة القاعدة – في تموز/ يوليو 2004 يهدد فيه موريتانيا مباشرة بالانتقام، قد مثل بالفعل اللحظة التي أصبحت فيها موريتانيا في مرمى خط النار بالنسبة لذلك التنظيم الجهادي الدولي.
بعد ذلك بأقل من سنة، حصل الهجوم على حامية عسكرية في بلدة “لمغيطي” في 4 يونيو 2005، جلب إلى طاحونة الأوضاع الأمنية في موريتانيا نصيبا هاما من القلق و مثله معه من الريبة و الشك. فعندما تعرضت وحدة من الجيش الموريتاني في الشمال الشرقي حوالي 150 كلم من الحدود مع مالي، لهجوم كاسح أدى إلى مقتل 15 جنديا و جرح 17 و 2 في عداد المفقودين، اعتبرها الرأي العام حينذاك مجرد مناورة سياسية من طرف نظام ولد الطايع، للتلويح بتهديدات إرهابية قصد تبرير التضييق على الحريات العامة و الحصول على معونات سخية من صندوق الحرب على الإرهاب.
بل لقد طالت حملة التشكيك تلك نوايا و أفكار الزعيم السابق للجماعة السلفية للدعوة و القتال و أميرها في الجنوب الجزائري مختار بلمختار نفسه، مع أنها كانت واضحة بما فيه الكفاية للتنبؤ بتطورات دراماتيكية قد تتجه نحوها الأوضاع المتسمة بتزايد انعدام الأمن في البلاد وفي شبه المنطقة عموما. ببساطة، لقد تبنت الجماعة السلفية للدعوة و القتال الهجوم على “لمغيطي” و دعت إلى طرد الأميركيين من منطقة الساحل وكبح وجودهم العسكري المتنامي في مناطق “كاؤو” في مالي و “اغاديس” في النيجر و “النعمة” في موريتانيا… و لكنها لم تجد من يصدقها آنذاك.
ثم توالت العمليات المحسوبة على القاعدة في موريتانيا. في 24 دجمبر 2007 اغتيل أربعة مواطنين فرنسيين من أسرة واحدة قرب مدينة “ألاك” في هجوم نفذه ثلاثة شبان موريتانيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. و في 27 دجمبر 2007 وقعت سيارة استطلاع تابعة لثكنة “الغلاوية” في الشمال، قرب مدينة وادان في كمين للقاعدة أسفر عن مقتل 4 عسكريين. و في مارس 2008 هوجم مقهى قرب السفارة الإسرائيلية في انواكشوط و جرح فيه شخصان، و في 6 و7 إبريل 2008 جرت اشتباكات دامية في شوارع نواكشوط بعد أن انتقلت المعاركة إلى العاصمة. و في 9 سبتمبر 2008 وقعت وحدة من الجيش الموريتاني في كمين قرب بلدة “تورين” بالشمال، أسفر عن مقتل 11 جنديا موريتانيا في شهر رمضان و مثل بجثامينهم. و في 23 يونيو 2009 قتل مواطن أمريكي في انواكشوط ضمن عملية تبنتها القاعدة بعد يومين. و في سبتمبر 2009 استهدفت السفارة الفرنسية في انواكشوط بتفجير انتحاري. و في 29 نوفمبر 2009 اختطف ثلاثة رعايا إسبان على الطريق السريع الرابط بين انواكشوط و انواذيبو و تم اقتيادهم إلى معسكرات تنظيم القاعدة في شمال مالي، قبل أن يفرج عنهم بعد ذلك في إطار صفقة دولية معقدة. و في 25 أغسطس 2010 هاجمت القاعدة بسيارة مفخخة مقر قيادة المنطقة العسكرية في مدينة النعمة شرقي موريتانيا على الحدود مع مالي، وقد أسفرت العملية عن مقتل جندي موريتاني و جرح آخرين.
و رغم أن مؤشرات تنامي أنشطة “إرهابية” واضحة المعالم في موريتانيا، كان يفترض بأنها باتت مؤكدة منذ عدة سنوات بعد أول إعلان رسمي عن وجود تيار سلفي جهادي في موريتانيا سنة 1994، إلا أن الحكومات الموريتانية المعاقبة كانت تختار دوما سياسة المهادنة في وجه تلك التهديدات.
و كان الاتجاه السائد في الخطاب السياسي و الإعلامي الرسمي منصبا على إبراز الأسباب التي ساهمت تاريخيا في الحد من تصاعد التطرف والغلو الديني في بلاد شنقيط أمس كما في موريتانيا اليوم و تعداد فضائلها كما لو كانت قيما مطلقة تقع خارج الزمان و المكان.. و ربما اعتمدت الحكومة آنذاك على تقديرات مبالغ فيها حول أهمية بعض العوامل الاجتماعية والثقافية في لجم التطرف و الإرهاب، كطبيعة التنظيم القبلي للمجتمع و دور الطرق الصوفية إضافة إلى النزعة العفوية لدى الموريتانيين لمقاومة الإسلام المستورد، إلخ.…. و هكذا، منذ البداية، لم تتجه الأمور نحو إجراء تشخيص موضوعي للمشكلة يفضي إلى اقتراح سيناريوهات ملائمة و خطة عمل جدية في الوقت المناسب و بالإمكانيات المتاحة، لنزع فتيل عوامل الاختلال التي ستساهم في ما بعد في انتشار الإسلام السياسي الراديكالي في موريتانيا و معالجتها بشكل جذري قبل وقوع الكارثة.
في موريتانيا، كما في أماكن أخرى في العالم الإسلامي، يشكل القهر السياسي والظلم الاجتماعي و التخلف الاقتصادي نتيجة لفشل السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، أهم الأسباب المغذية للتطرف و الإرهاب كظاهرة مجتمعية منحرفة بغض النظر عن محتواها النظري أو الأيديولوجي إن وجد. كما أن تداعيات الأحداث الدولية المؤثرة مثل بشاعة الغزو الأمريكي لأفغانستان و العراق والصومال، والتحيز الظالم للغرب ضد العرب في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، تعتبر عوامل إضافية قوية ضاعفت من انتشار التطرف و الراديكالية في العالم الإسلامي. و تعمل تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، التي تبث على مدار الساعة، على نشر ثقافة العنف على شكل دراما سمعية و بصرية عبر الانترنت و التلفزيون و السينما، و وسائط أخرى كالأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية و أجهزة الـ MP3 و الأيبود و غيرها على تعبئة الجموع الفقيرة من الشباب المسلم كمادة خام لتتحول إلى وقود للتطرف والإرهاب عبر العالم.
وهنا تكون القاعدة قد نجحت فعلا في تحقيق بعض أهدافها الإستراتيجية الهادفة إلى تعبئة المخزون الهائل من الإحباط السياسي والغضب الشعبي و الشعور بالحرمان و تنامي الكراهية على نطاق واسع ضد السياسات الغربية و خاصة الأميركية، المتسمة بالراديكالية و العجرفة على امتداد العالم الإسلامي، عبر تجنيد آلاف الشباب المسلم الذين يعيشون ظروفا اجتماعية و اقتصادية قاسية و لا يرون أمامهم ضوء في نهاية النفق غير التسلل عبر قوارب الموت للوصول إلى الشواطئ الأوروبية أو الجهاد في سبيل الله ضد المصالح الغربية.
سيناريو التدويل في الساحل
هل تمتلك موريتانيا – و هي الحلقة الأضعف في المنطقة- الإرادة السياسية الحازمة و الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجستية و التكنولوجية اللازمة لتجسيد خياراتها الإستراتيجية و العسكرية و الأمنية على أرض الواقع؟ أم سيقتصر دورها فقط على إشعال فتيل الحرب على القاعدة في الساحل من أجل تدويل قضية الإرهاب في هذه المنطقة لتبرير تدخل عسكري دولي؟
إن استقراء موضوعيا للمعطيات المتاحة يؤكد حصول عدة تغيرات جيوسياسية هامة حدثت في المنطقة و لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الموقف العام من الناحية الإستراتيجية. و تتعلق هذه المعطيات بتطور الفاعلين الإستراتيجيين المعنيين من جهة، و بتغير طبيعة التهديدات الأمنية نفسها و كذا بتطور مفهوم الأمن و الدفاع من جهة أخرى.
– أولا: عملت القاعدة منذ عدة سنوات و تحت تأثير الضغط عليها في المشرق الإسلامي (أفغانستان، الجزيرة العربية، العراق، اليمن) على نقل ثقلها التعبوي و الميداني من منطقة الشرق[8] نحو الغرب الإسلامي للبحث عن ملاذات آمنة في منطقة الساحل الإفريقي. و بالفعل، كانت تلك المنطقة من العالم المسحوقة و المنسية قد تحولت في العشرين سنة الماضية إلى مسرح كبير للإرهاب و لأعمال العنف المختلفة وكذا لأنشطة إستخباراتية دولية للرصد والعمليات الخاصة في منطقتي المغرب العربي و دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. و يشكل الربع الخالي الذي هو بمثابة “وزيرستان” الساحل[9] في أقصى الشمال والشمال الشرقي من موريتانيا وامتداداته وصولا إلى إقليم آزواد في شمال مالي- الذي يقع على حدود أربع دول هي موريتانيا والجزائر و مالي والنيجر – فضاء مثاليا لإخفاء الرهائن الغربيين الذين يتم اختطافهم لحين تحريرهم بعد الحصول على فديات مالية معتبرة، و كذا منطقة تخزين وعبور لآلاف الأطنان من المخدرات القادمة من إفريقيا و أمريكا اللاتينية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي عبر شواطئ موريتانيا والمغرب والجزائر و ليبيا. فهناك في “وزيراستان” الساحل، حيث تنمحي الحدود بين الدول عبر متاهات الرمال المتحركة، توجد جنة حقيقية لشبكات دولية متعددة]10 [ تنشط في مجال تهريب المهاجرين السريين و أنواع الممنوعات كالمخدرات و السجائر و المحروقات و الأسلحة النارية و الذخيرة ، فضلاً عن كونها تشكل ملجأ للهاربين من العدالة والمتابعة الأمنية في دول المنطقة. لذا فقد وضعت القوى الإقليمية والدولية المختلفة عينها على هذه المنطقة الإستراتيجية التي ستكون لها الكلمة الأخيرة من الناحية الجيوسياسية في تحديد مستقبل الإستقرار في منطقة الساحل خلال العشرية القادمة .
– ثانيا: استطاعت شبكات التهريب الدولية المذكورة أن تتكيف مع الظروف القاسية للساحل الصحراوي و أصبحت تعتمد على بعضها البعض ضمن إستراتيجية شاملة و معقدة من أجل البقاء، تتجاوز الخصوصية التنظيمية لكل شبكة على حدة. وهكذا تتساند شبكات التهريب الدولية هذه فيما بينها و توظف قدرات و خبرات بعضها البعض من خلال تقديم وكلائها لخدمات مأجورة تحت الطلب ضمن ما يشبه دورة اقتصادية مغلقة خاصة بها، تتطور بسرعة نحو نوع من “رأسمالية الإرهاب” أو “اقتصاد الإرهاب الريعي”. كما يجدر بالذكر أن جميع تلك الشبكات قد تم اختراقها من طرف أجهزة مخابرات دول المنطقة و من وكالات الاستخبارات الدولية. و نظرا لهذا التداخل و التشابك الشديد، يتعذر حاليا التمييز]11 [ بين شبكة قد تتولى جمع المعلومات لصالح جهة ما و أخرى تضطلع بالجهاد أو تلك التي تختطف الرهائن أو تتاجر بالمخدرات أو بالأسلحة النارية، إلخ… و لعل صور تلفزيون القناة الإسبانية التي ظهر فيها المدعو عمر الصحراوي يقود سيارته بزهو مصطحبا رهينتين أسبانيتين بعد صفقة الإفراج عنهما، لتمثل خير دليل على قدرة تلك الشبكات على الانصهار في بوتقة واحدة تعتبر القاعدة المستفيد الأول منها ضمن صيغة “شركة القاعدة و أخواتها في الساحل”. كما يثبت ذلك الشريط أن ترحيل عمر الصحراوي من موريتانيا إلى مالي- التي أخلت سبيله على الفور- كان من بين الأسباب الرئيسية التي أدت بتنظيم القاعدة إلى إطلاق سراح الرهينتين الاسبانيين، إضافة إلى الفدية المالية، التي قدرتها بعض المصادر بمبلغ 10 مليون يورو، أكدت وسائل الإعلام الاسبانية أن مدريد دفعتها للتنظيم مقابل الإفراج عن الرهائن.
– ثالثا: لقد تطور مفهوم الأمن نفسه بشكل جذري من المنظور الاستراتيجي. فمع ظهور مفهوم “الأمن البشري” الذي ابتكرته الدبلوماسية الكندية أواخر تسعينيات القرن الماضي و تبنته هيئة الأمم المتحدة من خلال تقرير التنمية البشرية لسنة 2004، تغيرت النظرة االكلاسيكية لمفهوم الأمن والدفاع. تلك النظرة التي كانت تحصر وظيفة الأمن فقط في تأمين السلطة الحاكمة و الدفاع عن الحوزة الترابية للدولة على حساب أمن البشر أو الأفراد، أي الناس العاديين الذين هم المواطنون في ظل دولة القانون. فقد أصبح تركيز السياسات الأمنية الجديدة على أمن المواطن و تأمين احتياجاته أولا و قبل كل شيء، لتجعل من حفظ كرامته و احترام حقوقه و تحقيق طموحاته في التنمية المستدامة و رعاية مصالحه الحيوية المشروعة نقطة مرجعية لرسم السياسات العمومية في مجال الأمن. فهل تمتلك موريتانيا عقيدة وطنية للأمن القومي، أحرى أن تتوفر على إستراتيجية متكاملة “للأمن البشري” مدعمة بخطط عمل جاهزة للتنفيذ من أجل حماية الوطن بمفهومه المركب. لقد ظل مفهوم الأمن الوطني في موريتانيا غامضا، كما بقيت أغلب إيحاءاته سلبية بالنظر لطبيعة الممارسات الأمنية المتعسفة التي قادت البلاد إلى شتى صنوف التجاوزات و سوء استخدام النفوذ. و هكذا، ظلت وظيفة الأمن، التي يفترض أن تكون متكاملة أي القوة الناعمة و القوة الخشنة، مختزلة في نواتها العنفية كجهاز للقمع همه المطلق هو حماية الأحكام السياسية المتعاقبة و التنكيل بأفراد الشعب العاديين.
– رابعا: تطورت طبيعة التهديدات التي تمثلها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من مرحلة المشكل الداخلي المقلق لكل دولة على حدة إلى قضية إقليمية جيوسياسية بالغة الحساسية. و هذا البعد الإقليمي للقضية تم حتى الآن توظيفه في لعبة التجاذبات الإقليمية للعلاقات و المصالح الدولية السياسية و الاقتصادية و الأمنية مثل إشكالية العلاقات الثنائية الحذرة و المثقلة بتداعيات الماضي الإستعمارى بين الجزائر و فرنسا، و كذالك في ترجيح ميزان القوة في النزاعات الإقليمية و المحلية مثل إشكالية الصحراء الغربية بين المغرب و الجزائر و إشكالية حركات التمرد الطارقية في شمال مالي، خاصة بعد انفصال إقليم آزاواد و الإعلان عن استقلاله من طرف واحد. و تسعى قوى إقليمية و دولية عديدة منذ عدة سنوات لتدويل خطر القاعدة في منطقة الساحل ضمن إطار خطة عسكرية لعموم الساحل الإفريقي تسمى “مبادرة لمكافحة الإرهاب في الساحل”. و هي تشكل نواة للذراع المسلحة الأمريكية في دول جنوب الصحراء و الغرب الإفريقي. و تدخل في ذلك الإطار المناورات العسكرية المسماة بـ “فلينتوكس” أو “مدفع الحجر” التي شارك فيها سنة 2005 أكثر من 1000 عسكري من القوات الأمريكية الخاصة إلى جانب قوات افريقية متعددة الجنسيات. و بعد أن أصبحت القيادة العسكرية الأمريكية الجديدة لإفريقيا (AFRICOM) مستقلة، قامت بانجاز برنامج لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا و بوضع برنامج لأمن السواحل في خليج غينيا، كما رتبت أيضا لإقامة قواعد عسكرية في البلدان الإفريقية التي لديها إنتاج كبير من البترول أو تتوفر على احتياطات نفطية هامة. و هي تتفاوض حاليا لإنشاء مواقع عمليات متقدمة في كل من السنغال ومالي وموريتانيا و غانا و الغابون و ناميبيا على الحدود مع آنغولا من أجل تحسين مهابط الطائرات و تخزين الوقود و إيجاد تفاهمات مع الحكومات المحلية تسمح بالانتشار السريع للقوات العسكرية إذا اقتضى الأمر ذلك. و تهدف كل هذه الجهود إلى ضمان السيطرة الأمريكية و الأوروبية على الطريق الغربي للنفط و كذا على المواقع الجديدة والحيوية لاحتياطيات النفط المكتشفة مؤخرا في تلك المنطقة.
من القاعدة إلى لعنة النفط
هل نزلت لعنة الموارد الأحفورية كالنفط و الغاز على موريتانيا في اللحظة غير المناسبة؟ و كيف السبيل إلى طرد عفاريت النفط والغاز التي بدأت تخرج من قمقمها في الصحراء لتؤجج صراع المصالح و المنافع المتفقة حينا و المتضاربة أحيانا أخرى بين القوى الدولية و الإقليمية؟ و هل ستذهب موريتانيا ضحية للحرب على القاعدة لتدفع ثمن متغيرات التنافس و التحالف بين الأميركيين والفرنسيين في سبيل السيطرة السياسية والعسكرية و الاقتصادية على شبه المنطقة و على مواردها الطبيعية لضمان تدفق إمدادات الطاقة الضرورية نحو تلك الدول و المحافظة على مكانتها و نفوذها كقوى دولية اقتصادية و صناعية كبرى؟
هكذا ظل الأمر دائما في كل زمان و مكان: البنادق تسير على خطا التجارة. فبعد أن دخلت شركات النفط الغربية العملاقة مثل مجموعة توتال الفرنسية التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 12 مليار يورو و يتجاوز عدد عمالها 90.000، في سباق محموم من أجل الحصول على نفط منطقة الغرب الإفريقي، ها هي تطالب بتأمين الأمن والاستقرار كشرط ضروري للقيام بأنشطتها و تأمين استثماراتها. و وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تعمل القيادة العسكرية الأمريكية لأوروبا حاليا مع غرفة التجارة الأميركية على توسيع نفوذ الشركات الأمريكية في إفريقيا، كجزء من “إستراتيجية وطنية مندمجة للاستجابة”. و في هذا السباق الاقتصادي المحموم للسيطرة على موارد النفط في إفريقيا، تدخل الدول الاستعمارية السابقة و غيرها كبريطانيا و فرنسا، فضلا عن الصين، كل حسب مصالحها القومية، في تنافس شديد مع الولايات المتحدة.
و تبعا لتقرير]12 [ صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية سنة 2006 تحت عنوان بالغ الدلالة “أكثر من الإنسانية: مقاربة إستراتيجية أميركية تجاه إفريقيا”، فإن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من المرجح أن تصبح مصدرا لتزويد الولايات المتحدة بالطاقة بمستوى أهمية الشرق الأوسط مع نهاية العقد الحالي.
و ترجح بعض مراكز الدراسات الإستراتيجية الأمريكية بأن غرب إفريقيا يحتوي على زهاء 60 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، وهو خام خفيف منخفض الكبريت يحظى بتقدير كبير لدى المصانع الأمريكية وكبريات شركات التزويد بالطاقة.
و يتوقع الخبراء ]13 [أن برميلا واحدا من بين كل 5 براميل من النفط يدخل دائرة الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العقد الحالي سيأتي من خليج غينيا، و أن حصة الواردات الأمريكية من النفط القادمة من تلك المنطقة سترتفع من 20% سنة 2010 إلى 25 % سنة 2015. خاصة إذا علمنا بأن صادرات نيجيريا وحدها تمثل حاليا 10% من إمدادات النفط التي تستوردها الولايات المتحدة، كما توفر آنغولا 4%، ومن المتوقع أن تتضاعف حصتها بحلول نهاية العقد الحالي. كما أن اكتشاف احتياطيات بترولية جديدة مهمة، خاصة في غانا و كذا التوسع في إنتاج النفط الذي تقوم به بلدان أخرى في المنطقة يزيد من فرص تصدير النفط إلى الغرب، و تشمل هذه البلدان كلا من: غينيا الاستوائية و وساو تومي و برينسيبي والغابون والكاميرون و موريتانيا و تشاد و السودان.
إن تصعيد الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا كثيرا ما يبرر بضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لتنامي عدم الاستقرار في المنطقة النفطية من إفريقيا جنوب الصحراء. و قد نصت وثيقة “إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة” الصادرة سنة 2002 على أن مكافحة الإرهاب الدولي و الحاجة إلى ضمان أمن مصادر الطاقة للولايات المتحدة تملي عليها السعي لزيادة انخراطها في إفريقيا، كما دعت تلك الوثيقة إلى قيام تحالف طوعي من أجل إقامة ترتيبات أمنية خاصة في تلك القارة. كما أن فرنسا كانت قد أنشئت سنة 2003 آلية تسمى “فريق مكافحة الإرهاب” التابع لمجموعة G8 “Groupe d’action anti-terroriste” أثناء الرئاسة الفرنسية لتلك المجموعة. و يجري هذه الآلية سلسلة اجتماعات تشاورية مكثفة تشارك فيها مجموعات من الخبراء التابعين لفريق مكافحة الإرهاب من أجل تقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة خاصة بعد العمليات التي نفذها الجيش الموريتاني ضد القاعدة داخل الأراضي المالية في السنوات الأخيرة و كذا بعد الانفصال الحاصل في الشمال المالي و سيطرة القاعدة و متمردي الطوارق على إقليم آزاواد. و تدرس دول الاتحاد الأوروبي حاليا للمرة الأولى على أعلي مستوى]14 [الوسائل الكفيلة بتقديم مساعدة لدول الساحل التي تواجه إرهاب القاعدة في الساحل من أجل تأهيل قوات الأمن المحلية في النيجر وموريتانيا ومالي خاصة. و قد تعقد هذا الملف أكثر و تضاعفت حساسيته و خطورة تداعياته داخليا و خارجيا خاصة بعد تبنى مجلس الامن الدولي بالإجماع قرارا يسمح فيه بنشر قوة دولية في مالي دون تحديد جدول زمني لبدء عملية عسكرية في شمال مالي بهدف طرد المجموعات المتطرفة المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ ستة أشهــر.
و كان الكونغرس الأميركي قد وافق من قبل على تقديم دعم مالي لـ “مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء”]15 [ the Trans-Saharan Counterterrorism Initiative(TSCTI) بمبلغ 500 مليون دولار على مدى ست سنوات لدعم البلدان المعنية بمكافحة الإرهاب ضد التهديدات المزعومة لتنظيم القاعدة. و هذه البلدان هي الجزائر و تشاد و مالي و موريتانيا و النيجر و السنغال و نيجيريا والمغرب. و يهدف البرنامج المذكور إلى دعم قدرات هذه الدول في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات، فضلا عن مكافحة الإرهاب.
موريتانيا و.. مأزق الحلقة الأضعف
هل يسمح الوضع الراهن لموريتانيا، و الذي يتسم عموما بالهشاشة البنيوية للوظائف الحيوية الأساسية للدولة و بضعف الأداء الاقتصادي و المالي لمؤسساتها بشكل عام، أن تضطلع بعبء مواجهة عسكرية مع القاعدة في المغرب الإسلامي؟ هل هي مناورة لترحيل الأزمات الداخلية نحو رصيد المشاكل الخارجية إلى حين، أم هو ببساطة نوع من الهروب إلى الأمام؟ ألا تخشى الحكومة الموريتانية أن تضعف المواجهة مع القاعدة البلاد أكثر، لتتحول مجددا إلى ساحة مضطربة للتجاذبات الإقليمية بدل التفكير في إيجاد حلول متوازنة، عقلانية و فعّالة للتعامل مع تعقيدات الموقف الحالي و تداعياته المستقبلية؟
في موريتانيا، و بعد 52 سنة من الاستقلال، ما يزال موقع الانترنت المخصص لوزارة الدفاع الوطني حتى الآن خلوا من أي معلومات مفيدة يمكن أن تؤمن حدا أدنى من التعريف بمهمة هذه الوزارة السيادية، أحرى أن توفر نوعا من التواصل الإيجابي مع العالم الخارجي كما هو الحال بالنسبة لمثيلاتها في دول المنطقة ( أنظر مواقع وزارات الدفاع في مالي، السينغال، الجزائر، المغرب) و في دول العالم الأخرى. و كذلك، ظلت محاولات المؤسسة العسكرية الموريتانية للتواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي نادرة جدا و خجولة، و تقتصر على إصدار نشرة “أخبار الجيش” و تنظيم زيارات و عروض قليلة لبعض قادة الرأي العام الوطني على فترات متباعدة، و جولات ميدانية لبعض وكالات الأنباء و القنوات التلفزيونية في مناسبات معينة.
ولكن الحقيقة التي لا تخفى على أحد هي أن موريتانيا تعاني من مفارقات هائلة و تباينات حادة في طبيعة المعطيات الجغرافية و الديمغرافية مثل كبر حجم المساحة و ترامي المسافات في ما بينها، إذ تتجاوز مساحة البلاد أكثر من مليون كلم²، بينما تتجاوز الحدود البرية 5000 كلم، و يبلغ طول الساحل البحري على المحيط الأطلسي وحده 754 كلم، و طول الحدود على شاطئ نهر السينغال850 كلم. هذا إلى جانب ضعف شديد في الكثافة السكانية بمعدل 2,5 نسمة/كم² ويصل إلى صفر نسمة/كم² في كثير من مناطق البلاد، بالإضافة إلى انعدام و/أو ضعف الوسائل التكنولوجية واللوجستية مثل الأقمار الصناعية و أنظمة الرصد و التجسس و شبكات قواعد البيانات و أجهزة المراقبة و التنصت الإلكتروني، و قواعد التحكم و السيطرة العملاتية، و منظومات تحليل المعلومات، إلخ.
و تشير المصادر الإحصائية المتخصصة ]16 [ إلى وجود نقص حاد في البنى التحتية و المعدات و التجهيزات العسكرية]17 [، الأمنية و الدفاعية]18 [ تعاني منه القوات المسلحة و قوى الأمن في موريتانيا. كما يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري من أجل رفع الجاهزية التعبوية و القتالية لوحدات الجيش و قوى الأمن، و التي بلغت سنة 2003 نسبة 4,9% من الناتج الداخلي الخام للدولة، لتنخفض سنة 2009 إلى نسبة 3,9% فقط.
و تقدر دورية “كلوبال سكيوريتي GlobalSecurity” المتخصصة في الشؤون الإستراتيجية الدولية مبلغ الإنفاق العسكري في موريتانيا بـ 19 مليون دولار سنة 2005، بينما بلغ حجم الإنفاق العسكري لنفس السنة في الجزائر 3 مليار دولار، و في المغرب 2,3 مليار دولار، و في السنغال 117 مليون دولار، و في مالي 50 مليون دولار، و في النيجر 45 مليون دولار، و في إسرائيل 9,4 مليار دولار، و في تركيا 12,2 مليار دولار، و في ليبيا 590 مليون دولار، و في تونس 440 مليون دولار. و يتوقع أن تصل مخصصات الدفاع المقترحة في الميزانية الموريتانية لسنة 2013 إلى مبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
يظهر تشخيص الوضعية الإستراتيجية للبلاد أنها تعاني من اختلال بنيوي حقيقي يتمثل في عدم وجود هيكلة تنظيمية ناضجة وجادة للأمن والدفاع القومي من شأنها أن تكون قادرة حقا على التعامل مع التحديات التي تواجهها موريتانيا اليوم، أحرى أن تكون قادرة على تحقيق نصر يذكر في مواجهة عسكرية محتملة مع تنظيم القاعدة الذي أعيى القوى الدولية العظمى و كبدها خسائر بآلاف المليارات من الدولار في أفغانستان و العراق و الصومال وغيرها. و يكفي أن نشير مثلا إلى أن التكاليف المالية لمشاركة فرنسا وحدها – و هي دولة غير رئيسة في ائتلاف الحرب على الإرهاب في أفغانستان – كانت تقدر بـ 1,3 مليون يورو يوميا! ثم أن القوى الغربية المتورطة في الحرب على أفغانستان منذ عشر سنوات، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، تبحث الآن لنفسها عن مخرج مشرف و هي تتفاوض حاليا بصفة سرية]19 [مع طالبان!
لا شك أن موريتانيا ليست كالبلدان المجاورة الأخرى، و تختلف وضعيتها عن شقيقتيها الجارتين المغرب و الجزائر، و هذا واضح جدا مما تقدم ذكره. فمثل تلك البلدان لها تقاليد دولتية إدارية، أمنية و عسكرية عريقة جدا، و لها خبرت في حقل العلاقات الدولية تتجاوز قرونا من الزمن، فضلا عن مواردها البشرية و العلمية و المالية المعتبرة. إنها فعلا دول تمتلك عدة خيارات متاحة في مجال التعاطي مع موضوع الإرهاب و الجريمة المنظمة من بينها الخيار الأمني لمواجهة القاعدة أو غيرها. أما بالنسبة لموريتانيا، فسواء مع أو بدون تهديدات القاعدة، لا يمتلك هذا البلد في الوقت الراهن خيارا أمنيا ناضجا ضد أي تهديد أمني واقع أو محتمل أيا كان مصدره. وعدا عن المعطيات الإستراتيجية المذكورة آنفا، تعطينا قصة احتجاز شحنة الكوكايين التي تقدر قيمتها بـ 20 مليار أوقية، التي كانت تحملها طائرة صغيرة حطت فجأة في مطار العاصمة الاقتصادية انواذيبو سنة 2007 ثم اختفت، دليلا قاطعا على الضعف الشديد الذي تعاني منه أجهزة الأمن الموريتانية و على عدم فاعليتها. وقد بات معروفا أن الشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات ما فتئت تنقل الأطنان منها عبر طول البلاد وعرضها، بل و تقيم لها مطارات آمنة في الصحراء مستفيدة من الثغرات الأمنية الهائلة.
ببساطة، لم يسبق أن وضعت موريتانيا لنفسها إستراتيجية أمنية شاملة من هذا القبيل. و قد مضى نصف قرن من الزمان على استقلال البلاد و لما توجد بعد أي إرادة سياسية حقيقية لتتحمل بجدية هذه المسؤولية باعتبارها حاجة ملحة لوجود الدولة الموريتانية واستقرارها و استمرارها في المستقبل ضمن محيط إقليمي و دولي بالغ الاضطراب و التعقيد.
و هكذا، ضاعت على موريتانيا فرصة انتهاج سياسات عمومية جدية تخطط لتعبئة وتنظيم ونشر الوسائل العسكرية، البشرية منها و المادية كالتجهيزات و الآليات والمعدات التسليحية والتقنية و اللوجستية اللازمة لقطاع الأمن و الدفاع بشكل يتناسب مع الاحتياجات الإستراتيجية الحقيقة للدولة الموريتانية ضمن إكراهات موقعها و حدودها المعروفة.
كما أن مسؤولية تقييم و أخذ الحقائق الاجتماعية والاقتصادية و الإكراهات البشرية والطبيعية والجغرافية والجيوسياسية بعين الاعتبار في عملية بناء منطقي لمنظومة أمنية و دفاعية قادرة على الاضطلاع بمهام “الأمن البشري” للجمهورية والدفاع عنها، قد ظلت حتى الآن انشغالا غائبا في مشروع الدولة الموريتانية المعاصرة. و يرجع ذلك لأسباب كثيرة تتعلق بضعف الموارد المالية للدولة و تعدد أولوياتها في مجال التنمية و كذا نقص الوعي لدى أغلبية النخب المسؤولة عن صناعة القرار بقيمة و أهمية التراكم المعرفي الإستراتيجي، و عدم الاهتمام بتطوير البحث العلمي وانعدام مراكز البحوث المتخصصة و نقص التدريب المهني و ضعف مستوى القدرات و غياب التأهيل المهني المستمر للكادر البشري. هذا طبعا، بالإضافة إلى عامل الخوف المزمن لدى أنظمة الحكم المتعاقبة من القوة المحتملة للجيش و قوى الأمن في بلد له تقاليده المعروفة في الانقلابات العسكرية.
باختصار، إن القدرات العسكرية على الاستجابة الفورية لتهديدات أمنية جدية و خطيرة ـ مهما كان مصدرهاـ تستهدف وجود الدولة الوطنية الموريتانية في الصميم كالجريمة المنظمة و الإرهاب و تهريب المخدرات و الاتجار غير المشروع بالممنوعات والهجرة السرية، الخ.…، لم تحظ حتى بالاهتمام السياسي النوعي المطلوب. و لم يسبق أن سجل هذا الشكل من المشاريع ضمن أولويات السياسات العمومية بالنسبة للأحكام المتعاقبة على هذه البلاد طيلة الخمسين سنة الماضية.
أما في ظل التطورات الجيوستراتيجية الجارية، فيتحتم على النخب السياسية و على صناع القرار في موريتانيا أن يواجهوا هذا الواقع الإستراتيجي بشجاعة أدبية و صدق مع النفس و مع الرأي العام الوطني الذي ينتظر منهم ذلك. فالبلاد لا تمتلك حتى الآن عقيدة وطنية راسخة للأمن القومي، أحرى أن تتوفر على إستراتيجية متكاملة “للأمن البشري” مدعمة بخطط عمل للتنفيذ و بجاهزية عالية على مستوى الأفراد و الوسائل و اللوجستيك و المعدات و اللوازم المطلوبة. بل، لقد ظل مفهوم “الأمن الوطني” في موريتانيا جامدا وغامضا و سلبيا في كثير من الأحيان. كما أن التوظيفات السياسوية “politiciennes” للممارسات الأمنية على أرض الواقع قد قادت البلاد فيما مضى إلى شتى صنوف التجاوزات و التعسف، و خلفت سمعة سيئة في المخيال الجماعي لدى الأهالي. و هو ما أدى إلى أن تظل هياكل و وظائف الدولة المتصلة بالقطاع الأمني مختزلة في نواتها القمعية بعيدا عن هدف تنمية قدرات و خبرات أمنية حقيقة يستفيد منها الوطن و يضمن بها استقراره و يصون بها كرامة مواطنيه بين الشعوب و الأمم.
هذه الحقائق المرة لواقع السياسات الأمنية و الدفاعية في موريتانيا لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تشكل مبررا أو غطاء لأي قرار قد تتخذه على عجل و تحت تأثير الصدمة أو الضغوط الخارجية، الحكومة الحالية أو أية حكومة أخرى قد تأتي بعدها. فلا مصلحة لموريتانيا في التورط مع أي ائتلاف أمني ـ عسكري تحت ذريعة الحرب على الإرهاب] 20[ في منطقة الساحل. و لا يمكن لمثل تلك القرارات المغامرة أن تكون من الحكمة و لا من الرشاد في شيء. بل، لقد ثبت فشلها في أنحاء عديدة من العالم و جلبت الخراب و الدمار للبلاد و العباد في الصومال، و أفغانستان، و العراق، إلخ. و هي فضلا عن كونها ستبقى مرفوضة من طرف الرأي العام الوطني والطبقة السياسية الشريفة، فهي لا يمكن أن تمثل الجبهة الحقيقة التي يتوجب على موريتانيا أن تحشد لها العدة و تعلن لها النفير. و سيظل من الأولى أن تكون حرب موريتانيا الحقيقية و جهادها و تحالفها هو أساسا ضد التخلف و الفقر و الجهل و المرض و البطالة و التهميش و الظلم والغش و التلاعب بالمصالح العليا للشعب و الأمة.
إن موريتانيا بحاجة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى تغيير نظرتها إلى الأمور كدولة، ليس بطريقة تلمس الخطأ و الصواب، بل بشكل منهجي مدروس يهدف إلى إعادة صياغة و ترميم عميق لسياساتها الأمنية والدفاعية فضلا عن تدبير دبلوماسيتها على الصعيد الدولي بطريقة علمية، مهنية و فعالة كما يفعل الآخرون. إن قضايا الأمن و الدفاع و السياسة الخارجية و الدبلوماسية في الحقيقة هي مجالات بالغة الحساسية و لا يمكن أن تنسجم مع غلبة الارتجال و اللامبالاة و غياب المهنية، و انتشار التعامل الزبوني.
لم يعد في الإمكان تأخير إصلاح حقيقي يطال جوهر و شكل السياسات العمومية المذكورة، فقد حان الوقت لأن تتغير النظرة الضيقة للأمن وللدفاع في موريتانيا، المحصورة تقليديا في أمن السلطة الحاكمة و أمن الإقليم الترابي على حساب الاهتمام بأمن البشر أو المواطنين العادين في ظل دولة القانون. إن مثل هذا التغيير في الأفق، يقتضى من الآن فصاعدا أن تركز السياسات العمومية أولوياتها على الأمن البشري أي أمن المواطن أولا و قبل كل شيء.
إن مستقبل البلاد مرهون اليوم بإدخال إصلاحات عميقة على كيان الدولة الموريتانية من أجل إعادة هندسة وظائفها الرئيسية من النواحي الإيديولوجية و الإستراتيجية و التشريعية، و المؤسسية. و هذه المقاربة تمر حتما ـ من بين أمور أخرى ـ بإنشاء مجلس للأمن القومي و “منظومة عملاتية” (opérationnel système) لتنسيق السياسات العمومية المدنية و العسكرية و لإنضاج الأفكار والقرارات واقتراح و ترشيد التوجهات والخيارات السياسية الداخلية والخارجية و الأمنية و الدفاعية. كما يتعين على الدولة إقامة و دعم معاهد الدراسات و البحوث الإستراتيجية و شبكات البحث المتخصص لتكون قادرة على إنتاج و إنضاج الأفكار و الخطط و المقاربات و المفاضلة بين الخيارات و السيناريوهات المتاحة و تقديم الاستشارة الإستراتيجية النوعية و التكوين و التدريب المهني في هذا المجال.
و كما هو معروف في عالمنا اليوم، فإن قوة المنافسة الدولية و الإقليمية لا ترحم، و هي تسحق الدول القوية أحرى تلك الضعيفة. أما تداعيات العولمة، فلا شك أنها تزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن مثل ظواهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالإرهاب، و تهريب المخدرات، و الهجرة السرية، إلخ…
و في مثل هذا السياق الحذر، يحتم الموقف الجيوستراتيجي]21 [الحساس على الحكومات الموريتانية أن تجتهد بصدق في حسن قراءة خارطة المعطيات و المؤشرات المتعلقة بقضايا الأمن الإستراتيجي و التهديدات الإرهابية للقاعدة و غيرها، قصد بناء السيناريوهات الممكنة لتسيير المواجهة على أسس علمية، و من ثم يتوجب عليها أن تعيد تقييم خياراتها على أساس المفاضلة الموضوعية في ما بين تلك السناريوهات، بما يخدم المصلحة الوطنية بكل مسؤولية و تجرد. فمصير الدولة التي قد لا تحسن المناورة هو أن يحكم عليها بالخضوع لمناورات دول أخرى عرفت كيف تجيد اتخاذ قراراتها [22].
و على كل حال، إذا لم تكن لدى الحكومة الموريتانية الإمكانيات اللازمة لتحقيق سياساتها في المجال الأمني و العسكري في الوقت الراهن، فلن يعيبها أن تتبنى سياسات تتناسب مع إمكانياتها.
أما الشعب الموريتاني الطيب، الذي احتفل بالذكرى الثانية و الخمسين لنيل الاستقلال الوطني من نير المستعمر الغاشم، فله أن لا ينسى أبدا الفارق الجوهري بين رجل السياسة و رجل الدولة، فبينما يفكر الأول فقط في مصيره في الانتخابات القادمة، يفكر الأخير دائما في مصير الأجيال القادمة!
محمد السالك ولد إبراهيم
استشاري في مجال العلاقات الدولية،
كبير باحثين/ المركز الموريتاني لأبحاث التنمية و المستقبل
[email protected]
——————————————
المراجع و الهوامش:
[1] بدعم من قوات الكوماندوس الفرنسية، قام الجيش الموريتاني في 22/7/ 2010 بهجوم على معسكر تابع للقاعدة داخل الأراضي المالية أسفر عن مقتل 7 من عناصر التنظيم .و قد بررت الرواية الرسمية الموريتانية العملية بأنها إستباق لإحباط هجوم وشيك للقاعدة على حامية عسكرية موريتانية. أما الرواية الفرنسية، فتشير إلى إنها كانت محاولة لتحرير الرهينة الفرنسي “ميشيل جيرمانو” الذي أعدمته القاعدة رداً على العملية. و قد أيدت الولايات المتحدة العملية العسكرية الموريتانية – الفرنسية وأعلنت أنها تقاسمت معلومات استخباراتية مع البلدين بشأنها .أما الجزائر فقد أعربت عن استيائها البالع من العملية و خاصة مشاركة قوات أجنبية فيها. أما معركة “رأس الماء” فقد جرت في 17 و 18/9/ 2010 على الحدود بين موريتانيا ومالي ثم انتقلت إلى بلدة أحسي سيدي المالية على بعد مائة كلم شمال تومبوكتو في إقليم آزاواد. واستؤنفت في اليوم التالي في منطقة رأس الماء على بعد 235 كلم إلى الغرب منها. و يبدو أنها كانت المعركة الأعنف حتى الآن في المواجهة بين الطرفين. و قد جرى استخدام طائرات حربية موريتانية و تضاربت الروايات عن حصيلة القتلى و الجرحى التي يعتقد بأنها كانت مرتفعة في صفوفهما.
[2] Jean-François Bayart , L’État en Afrique : la politique du ventre, édition Fayard – 2006, p 439.
[3] مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا: د. محمد الأمين ولد سيدي باب، الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- ايلول/ سبتمبر 2005
[4] Ernest Psichari, Terres de soleil et de sommeil, Paris, Ed. Calmann Lévy, 1908.
[5] القاعدة في موريتانيا..من التأسيس إلى محاولات الوصول إلى السلطة، خليل ولد جدود – اسلام أون لاين – نقلا عن جريدة الحياة اللندنية
[6] Rapport Andreotti sur l’Opération Gladio in “Les Armées Secrètes de l’OTAN”, Daniele Ganser, éditions Demi-lune, 2007.
[7] “الجدار الأخضر العظيم” لصدّ التصحر عن أفريقيا، محمد السالك ولد ابراهيم – مجلة البيئة والتنمية، عدد شباط / فبراير 2009 – بيروت – صحيفة الحياة، لندن.
[8] مستقبل عمليات تنظيم القاعدة في آسيا وأفريقيا – دراسة – أغسطس 2010
[9] إقليم “أزواد” المالي . . وزيرستان الساحل: المختار السالم – صحيفة الخليج – أغسطس 2010
[10] عبد المالك سايح: “الساحل أصبح منطقة عبور للكوكايين و الهيروين”
[11] في 25 فبراير 2010 اعترضت قوات موريتانية قافلة من السيارات تهرب المخدرات تحت حماية عناصر من القاعدة في أقصى الحدود الشمالية الشرقية مع الجزائر و مالي، و قتل في العملية المعروفة بـ”لمزيرب” 4 أشخاص واعتقل 18 آخرين كما تمت مصادرة 9 أطنان من المخدرات وكميات من الأسلحة و التجهيزات المختلفة و عرضت صور العملية في التلفزيون الموريتاني.
[12] Task Force Report: More Than Humanitarianism A Strategic U.S. Approach Toward Africa, (Princeton N. Lyman J. Stephen Morrison),
Publisher: Council on Foreign Relations – 2006.
[13] African Oil: A Priority for U.S. National Security and African Development, Institute for Advanced Strategic &
Political Studies symposium, 2002.
[14] أدرجت قضية تهديد القاعدة لدول الساحل الإفريقي على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في شهر أكتوبر 2011 بلوكسمبورغ. وقال مصدر دبلوماسي إن الوزراء “سيدرسون خيارات عدة ممكنة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي من اجل المساعدة على إحلال الاستقرار في المنطقة”
[15] Global Security : Trans-Sahara Counterterrorism Initiative [TSCTI]
[16] Mauritanie: Forces armées Profil 2008
[17] NationMaster.com: Statistics on the basis of data on armed forces from IISS (International Institute for Strategic Studies), 2001.
[18] Mauritanie : forces terrestres équipements et véhicules armée mauritanienne
[19] الحوار مع طالبان.. تفاوض أو استمالة؟ – مركز الجزيرة للدراسات – 2010
[20] La Mauritanie, Al-Qaïda et les autres, Mohamed Saleck OULD BRAHIM – MULTIPOL, Genève 2008.
[21] Stratégie et enjeux d’Al-Qaïda en Mauritanie : Benoit Lucquiaud, Institut supérieur de relations internationales et stratégiques (ISRIS) – Août 2010.
[22]سقط إقليم آزاواد بمدنه الرئيسية ( تمبكتو، كاوو، ) منذ 6 اشهر بأيدي المتمردين الطوارق ومجموعات إسلامية مقاتلة، إلا أنه بات تحت سيطرة كاملة لعناصر مجموعة أنصار الدين المدعومين من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتمكنت مجموعة أنصار الدين والقاعدة من طرد مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد من تمبكتو. وفي حين أن هذه الحركة تعتبر نفسها علمانية وتطالب بدولة للطوارق، فإن الإسلاميين في أنصار الدين والقاعدة يطالبون بتطبيق الشريعة على كافة أراضي مالي.






















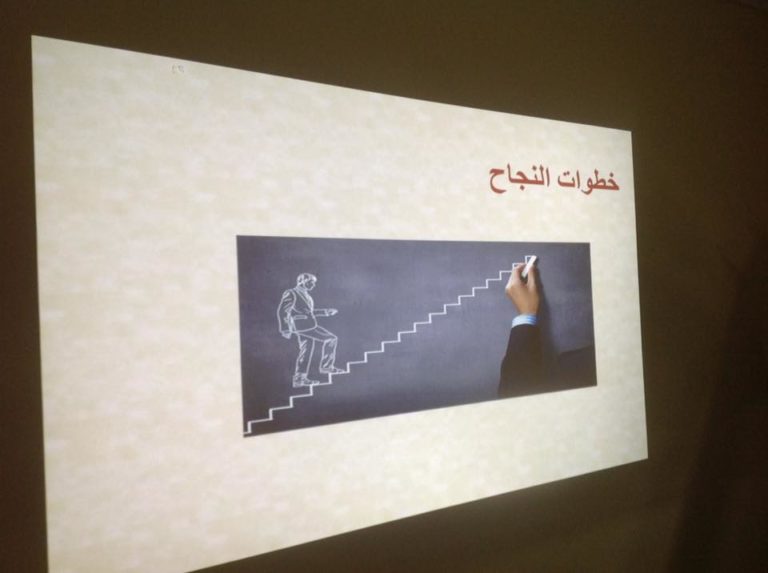






















































![مركز مبدأ ينظم طاولة مستديرة حول [التجديد و فقه السلم في مشروع العلامة الشيخ عبد الله بن بيه] مركز مبدأ ينظم طاولة مستديرة حول [التجديد و فقه السلم في مشروع العلامة الشيخ عبد الله بن بيه]](https://mabdae.info/wp-content/uploads/2017/04/17309879_980313498765900_7107191782481884978_n.png)



















