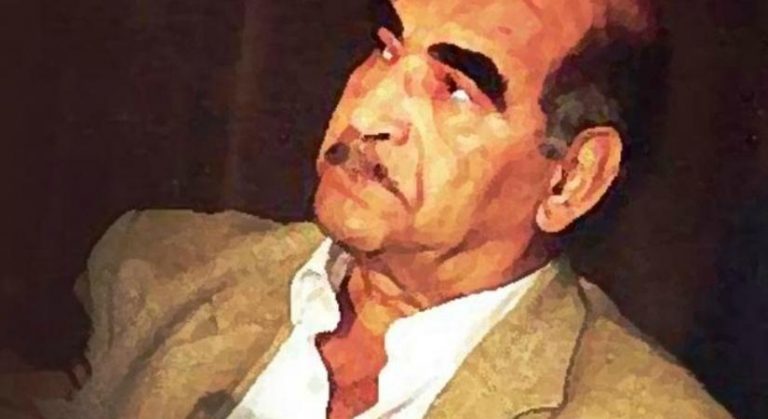أبو العباس ابرهام
لعلّ مصطلح “الربيع العربي” الذي أذاعه، وإن لم يكن ابتكره صحفي “نيويورك تايمز”، توماس فريدمان (ذلك أن مجلة “فورين بوليسي” سبقته إليه)، [1] يعمد إلى حجب وتغميض العناصر غير العربيّة في موجة الحراك العربي الكبير بدءًا من أواخر 2010 التي عمّت معظم أجزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتجاوزتها إلى نواحي غيرها.[2] ففيما تُنسيِ صفة “فورين بوليسي” وفريدمان هذه أنماط الحراك الكردي والتركماني والدرزي والأشوري في هذه الأحداث في المشرق العربي فإنّ ضحيّتَها الأهم في “المغرب العربي” كانت الحراك الأمازيغي.
تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن جوانب من هذه الطفرة الأمازيغية من خلال البت في خصوبة تجربتها التاريخية وتعدُّدِّها مع النظر إلى بعضِ جوانبها المتعلِّقة باللغة والهوية. سأحاجِجُ فيما يأتي أنّ الرّبيع العربي تصاحب مع حِراك أمازيغي كبير في أرجاء من المغرب العربي. وسأتقصّى الجذور التاريخية لهذا الحِراك قبل أن أعرج على بعضِ محدِّدات وتناقضات هذا الرّبيع وعلى بعض إشكالياتِه بصفة عامّة.
1- الرّبيع الأمازيغي
وفي الحقيقة فإن صفة “الرّبيع”، الذي هو مصطلح ليبرالي طُرِحَ منذ “ربيع براغ” 1968 للترحيب بالتحركات الشعبية ذات المطالب الليبرالية،[3] قد أُطلِقت أوّل ما أُطلِقت في “المغرب العربي” على التحركات الشعبية الأمازيغية. ولعلّ حراك الأمازيغ في 1980 “منطقة القبائل” شمال شرق الجزائر، وخصوصاً احتجاجات الشباب ونشطاء المجتمع المدني في “تيزي وزو”، شمال الجزائر، ضّد حظر مظاهرٍ من الثقافة الأمازيغية وللمطالبة بالاعتراف بالخصوصية الأمازيغية كان أول “ربيع” في المنطقة العربية، وسيعرف منذئذٍ عالمياًّ بـ”ربيع البربر” أو “الربيع الأمازيغي”. ويعودُ لنا مصطلح “الربيع الأمازيغي” مرة أخرى، وإن كانَ قد وُصِفَ بـ”الرّبيع الأسود” هذه المرة، ليصِفَ الحراك الأمازيغي في 2001 في منطقة القبائل مرّةً أخرى، حيث سقطَ عشرات الضحايا احتجاجاً على عنف رجال الدرك والشرطة ضدّ المحتجين الأمازيغ.
ولا تختفي عناصر “الرّبيع الأمازيغي” حتّى مما أصبحَ يُطلَقُ عليه اختزالاً “الرّبيع العربي”. ففي هذا الربيع في المغرب حقّقت الحركة الأمازيغية في 2011 أهمّ انتصارٍ لمجموعة غير عربية في البلدان العربية بعد أكراد العراق، غداة الاعتراف بالأمازيغية لغةً رسمية في دستور 2011، وهو اعتراف جاء عشية دخول أمازيغي كبير في حركة الاحتجاج الشعبي في فبراير 2011. وفي ليبيا، ذاتِ الأقليّة الأمازيغية، استطاع أمازيغ “جبل نفوسة”، شمال غرب ليبيا، بعد التحاقٍ بالثورة على نظام القذافي، الذي طالما أنكرَ الحقوق الثقافية والسياسية الأمازيغية، أن يمارسوا سيادةً محلية سمحَت لهم بإدخال اللغة الأمازيغية في التمدرس المحلي إضافة إلى إطلاق نشرات إذاعية بالأمازيغية. ولا شكّ أن هذا يعود إلى توطٌّدِ الأمازيغ الليبيين قوةً عسكرية مستقلة عن الجيش الليبي تتمتّعُ بنفوذها ورهاناتها وتحالفاتها العسكرية والسياسية. وإذا كان الإعلان الدستوري في أغسطس 2011 لم يجعل من الأمازيغية لغة رسمية كما أمِلَ أمازيغ ليبيا إلاّ أنه وعد بالحقوق اللغوية والثقافية للجميع، وجعلِ من الأمازيغية لغة “وطنية”.[4] وفي تونس أظهر أمازيغ “جربة” في “مطماطة” و”عرقوب السعادنية” البالغين أقلّ من 2٪ من السكان، أنفسهم للعالم، مُكسِّرين أسطورة التجانس العرقي واللسانية المؤسِّسة للقومية التونسية، وذلك عشية هروب بن علي، مؤسِّسين “الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية”، التي، مع ترخيصها، بدأت ما وُصف بأنه نهضة ثقافية وفنيّة تونسية.[5] ورغم أنّ الهوية الأمازيغية قد اختفَت من السياسة الموريتانية منذ مطلع العصر الحديث، إلاّ أنّ الربيع العربي أيقظ اهتماماً إعلامياً غير مسبوق بالماضي الأمازيغي الموريتاني.[6]
وللمفارقة فإن ضعف “الربيع العربي” في الجزائر انعكس على ضعف إمكانات “الربيع الأمازيغي” فيها، مع أن الحركة الثقافية الأمازيغية بالجزائر هي جدلاً أقوى الحركات الثقافية الأمازيغية المغاربية وأكثرها مكاسب وثقة واعتداداً وتسييساً. ولعلّ هذا “التقاعس” الجزائري عائدٌ إلى كون مطالب تأهيل “التمازيغت” إلى لغة وطنية، وإن ليست “رسمية”، إضافة إلى مساحات التعبير الأمازيغي هو “مكسب” حقّقه “الربيع الأسود” الجزائري في 2001 عندما أذعنت حكومة بوتفليقة للاحتجاجات القبائلية وأطلقت بوتقة إصلاحات وتراخيص ثقافيّة.[7]وفي منطقة الصحراء الكبرى، وبفعل توسُّع تداعيات الحرب الليبية 2011، ثارت قوى الطوارق وأطلقت ثورتها الثالثة ضدّ النظام الحاكِم في جمهورية مالي وأسفرت لوقت وجيز عن توطيد كيان طارقي مستقل، قبل أن تؤدِّي قوى الإسلاميين المسلحين إلى تجاوز البعد القومي لثورة الطوارق واستبداله بمشروع قاعدي أو متفرِّع من “القاعدة”.[8]
2- في تقدم الهوية الأمازيغية
إذاً لم يحل “الربيع العربي” إلاّ وكانت الحركة الأمازيغية قد صارت بارزة وواضحة حتى للأباعد، مستدعية بذلك ثقة هوياتية وطفرة في الدراسات الأكاديمية وباعثةً به وحدة ثقافيّة، إن لم تكن أمميّة أمازيغية، على مستوى المغرب العربي ومنطقة الصحراء الكبرى. ويمكن المحاججة أن هذا النجاح السياسي النسبي للحركة الأمازيغية يُعبِّر عن نجاح في أممية ثقافية للأمازيغ[9]. وبدوره يعود هذا إلى تراكم تاريخي مُطّرد. وفي الحقيقة، فإن ظهور مصطلح “الأمازيغ” وصفاً لمختلف هويات “البربر” في أرجاء منطقة المغرب والصّحراء هو نجاح لمستوى أولي من القومية: وهو تخيل هوية موحدة متجانسة الوجدان واللسان والهموم. وهو بالأخصِّ نجاح الطبقة الوسطى في تخيّل نفسها طليعة و/أو امتداداً لمجتمع متكامل من خلال وسائط الرأسمالية الثقافية والطِّباعيّة، بالمعنى الذي أذاعه بنديكت أندرسون،[10] أو “ابتكار التقاليد”، بالمعنى الذي أذاعه أريك هوبزباوم: إنتاج تقاليد تُسْبَغُ عليها صفة القدامة وتُسقَطُ على التاريخ وتؤسِّسُه وتُصبحُ مرجعاً لتأسيس الأمة أو المجتمع.[11] سأستخدِمُ، وإن بإضمار ودون تجريد، هذين الإطاريْن لفهم ديناميكية الهوية الأمازيغية في عصر الحراك الجماهيري.
وإذا كان ما نشهده اليوم على مستوى تطوُّر الحركة الأمازيغية هو خلق وحدوية أمازيغية قادرة على التشكل والانتظام الثقافي، وربما السياسي، فإن جزءً أساسياً من هذه العملية هو تعميم وتوسيع المجال الشعبي الأمازيغي وإلحاق كيانات ومجتمعات البربر المتفرقة في المغرب العربي بهوية الطبقة الوسطى القبائلية والشلحية-الريفية التي، من خلال مثقفيها ومجتمعاتها المُهاجرة والمقيمة في المدن، أصبحت تتصدّر الثقافة وتعيد تعريف وإنتاجَ الأمازيغ وتوسيعَهم لشملِ كلِّ مجال “البربر” التاريخي. وفيما يُواصل أمازيغ ليبيا مثلاً مدّ أيديهم إلى “التبو” القاطنين بالجنوب الليبي والشمال التشادي والنيجري، والمنسوبين غالباً للبربر، ولكن المتمايزين لغوياً وسياسياً وثقافياً عنهم، فإن أمازيغ “القبايل” في الجزائر يواصلون أممية أمازيغية شبيهة بانتهاج قضية بربر الجنوب في منطقة “المزاب” وإجمالِها في قضيتهم. وتلوحُ أممية كهذه بين بربر “الريف” وبربر “الأطلس” في المغرب، رغم تبايناتِهم التاريخية والثقافية واللسانيّة. وتوجد حالة وجدانية بين أمازيغ الجنوب الجزائري والطوارق في مالي والنيجر، هي جدلاً ما يُعطي للدولة الجزائرية نوعاً من السلطة الناعمة في القضية الطارقية. ولا يندرُ حتى في الخطاب الأمازيغي المغاربي إسباغ الهوية الأمازيغية على بربر موريتانيا، رغمَ الاختلافات البيِّنة في مفهوم “البربر” واشتغالاته في المجال الموريتاني.
وإذا كانت الأممية الأمازيغيّة تقوم، مثلُها مثل أي حركة قومية، بتخيُّل الأمة من خلال هوية مشتركة وأصل واحد، فإن هذا-للمفارقة- ينعكس حتّى على ممارسات الدولة “العربية” المغاربية التي تقوم بمشروع توحيد لغة الأمازيغ، ضاربة عرض الحائط بالتواريخ والتشعبات اللسانية لهذه اللغات. ففي المغرب تريد الحكومة تقعيد التاشلحيت والتيريفيت والتمازيغت في إطار واحد هو لغة التامازيغت الممحوَرة نحوياً لتشمل كلّ المكوِّنات اللسانيّة المتضاربة. ولا شكّ أن هذه النزعة التعميمية والتقعيدية لهوية ولسان البربر تستمدُّ أثرها من رومانسيات قومية معينة. ولكنها، وكما يُظهرُ بعض دارسي الأيديولوجيات اللغوية في منطقة المغرب، وفي الثقافة الأمازيغية بالخصوص أمثال كاثرين هوفمان وبول سيلفرستين وسالم شاكر، أيضاً نتاج تلاقح معرفي-سلطوي (وهو شبيه بالنموذج الفوكوي) عملت فيه أنظمة المعرفة الغربية على إنتاج خطاب أثنوغرافي مَاهَى بين اللغات، عربية كانت أم بريرية، مع أنماط “ثقافة” معينة؛ ورتّبَ على هذا استنتاجات وممارسات وهويّاتٍ ثقافية معينة. ولا نقصد بهذا المفهوم الذائع، بل والمُبتذل، أن الأستعمار فرّقَ ليسود أو أنه أنتج هويات غير عربية ما كانت قائمة قبله. فالحقيقة أنه، وكما أظهر بعض الدارسين، فإن نطق الاستعماريين الفرنسيين وتمرُّسِهِم في اللغة العربية، وهو تمرُّس واكب عملية تحديث العربية في فترة ما يُسمّى بـ”النهضة”، رفعَ من مقام العربية وأذاعَها في الشعوب الأمازيغية وجعل قيمتها الاجتماعية تتجاوز استخداماتها الدينية إلى أخرى دنيوية وطبقية وصُعودية.
3- بين السهول والجبال: في التطور التاريخي للهوية البربر
ولكيلا يفهم القارئ هنا أن نموذج “المجتمع المتخيّل” الذي دافعنا عنه هنا يُقصي حقيقة و”موضوعية” الوجود التاريخي لـ”البربر” فإنه لا بدّ لنا هنا من التوّقُّفِ قليلاً للنّظر إلى هويات أمازيغية فيما قبل الحداثة. وطبعاً ليس هذا التوّقف من أجل القول إن الهوية/ـات كانت ثابتة قبل الحداثة ثمّ صارت مُحدّثة ومُنتَجَة ومُقعّدة فيما بعدها. بيدَ أنه من الصّعب إغفال تاريخ الثقافة الأمازيغية وكيف تكمكمت عبر مختلف الأنظمة السلطوية التاريخية، وكيف أنتجت تلك الأنظمة تصنيفات هوياتية بناءً على تصورات معرفية معينة سرعان ما أصبحت لها تجليات سياسية معيّنة أو صارَت هي تجلياتٌ لممارسات معيّنة. وقد نجح الرومان، عكس ما تُقدِّمُه الصورة القومية الأمازيغية والعربية، فيما قبل الإسلام في صهر نواة من البربر المتمدِّنين، وإن بقت ضئيلة، في الثقافة اللاتينية والمسيحية (لنفكِّرْ الآن في القديس أوغسطس ولوكيوس أبوليوس، وهما أمازيغيان أهديا أهمّ اللاهوت و”الرواية” الأدبية للحضارة الرومانية المسيحية). وبنفس الطريقة التحمَت نواة من البربر المتمدِّنين في دولة الفتح العربي. فيذكُرُ لنا المؤرِّخون العرب الوسيطون حضور الطاقم الخدمي من البربر في أمّهات وحشم وكتبة الخلفاء والأمراء وفي طبقات الفقهاء والجند. على أنّه برغم المبالغات بخصوص تمفصل البربر عن الإطار العربي في المنطقة المغاربية (وصلَ التداخل إلى درجة أن بعض اللغات الأمازيغية كانت تحوي نسبة 60% من اللغة العربية)، وكأنهما برزخان لم ينفذا إلى بعضِهِما، إلاّ أن هذه التصنيفات تبدو غالباً جليّة، وإن كانت متداخلة، في تاريخ المغرب (مثلاً خلقت الفتوحات الإسلامية نواة قتالية في البربر كانت أساسية في فتح الأندلس وصقلية ثم في تنازع السلطة مع العرب فيما بعد ذلك؛ واختلقت السلالات البربرية في المغرب والأندلس كالمرابطين والموحدين لنفسها أصولاً عربية أو تعرّبت في البيروقراطية والبلاط والزيجات الأندلسية).
ولا شكّ أنه كان هنالك أساس جغرافي لهذه الهويات الأمازيغية التاريخية المنفصلة، ولكنّه أيضاً لا يُفصل عن تواريخ الربيع الأمازيغي في القرون الوسطى. بل ويمكن القول إن هذا الأساس كان بمعنىً ما، وخصوصاً في تجلياتهِ الأخيرة، مُنتجَ الانتصار العربي على البربر في أواخر القرن الثامن الميلادي والثاني الهجري. فرغم نجاح العرب في أسلمة البربر (مع أن المؤرِّخ الجاد تاديكي لفيسكي يوضِحُ أن هذه الأسلمة استغرقت قروناً، وليس مجرد سنوات كما في الأيديولوجيا الإسلامية التاريخية) إلاّ أن تعريبهم تأخّرَ كثيراً عن أسلمتهم. بل وإن هويات سياسيّة للبربر سرعان ما بدأت تظهر في سياق النظام الإسلامي المتوطِّدْ، ذلك أن بربر المغرب قد راهنوا منذ القرن السابع على أنماط غير معيارية من الإسلام للدفاع عن خصوصيتِهم ضدّ العرب. وسرعان ما اعتنق بربر المغرب الإباضية والصفرية في العهد الأموي وأشعل ميسرة السقاء (ت 122 هـ)، الذي بايعه البربر أميراً، وعكاشة الخارجي ثورة خوارجية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الثامن الميلادي امتدت من المغرب حتى تونس.[12] وسرعان ما أفضت هذه الثورات إلى خلق أوّل الدّول الإسلاميّ’ المستقلّة عن العبّاسيين: الدولة المِدرارية الصفريّة والدولة الإباضية في غرب ليبيا وشرق تونس، في عام 144هـ. والأخيرة سرعان ما هاجرت بعد هزيمة العبّاسيين لها إلى غرب شمال الجزائر، وتحديداً في تاهرت، تيارت الحاليّة، وستعرَف بالدولة الرستميّة.[13] ولعلّ تداعيات هذا خلقت الأساس المجغرف لثنائية البربر والعرب، وخصوصاً عندما نجح المشروع العباسي في إنفاذ موجة جديدة من الجنود العرب من خراسان (إيران) هم الأغالبة الذين استطاعوا إخماد موجات الثورات البربرية التي اشتعلت من المغرب حتى إفريقية (تونس) مروراً بـ”مْزاب” (وسط الجزائر).[14]
ولاشكّ أن انكفاء البربر اللاحق في الممالك الخارجية الهامشية كالرستميين في “المغرب الأوسط” ثم في “مْزاب”، والذين بايعهم بربر “جبل نفوسة” إضافة إلى غلبة الممالك العربيّة أو المتعربة في الأصقاع المدنية فتحّ المجال للحركة الدينية الاجتماعية المتأسِّسة في الرباطات والزوايا، والتي سرعان ما تطوّرت إلى سلالة السعديين في القرن السادس عشر في المغرب فأعطوا دفعاً للتعريب وإبعاد البربر. وعموماً توطّدت هوية البربر في المغرب في المناطق الوعرة والقصيّة على “الفتح العربي” و”العثماني”. وسيكون لهذا مترتبات على مستوى ربط العروبة بالمجال العام والأمازيغية بالمجال الريفي أو المُخصخص. غير أن هويات البربر هذه بقيّت مشتّتة في جزائر متنائية، وأحياناً متجافيّة، ما بعّد التلاقيات اللسانيّة بينها وقسّمها إلى جُزُر ثقافيّة ولسانية لا تتفاهم فيما بينها.
على أن عزل البربر أيضاً حافظ على خصوصياتِهم الثقافية واللسانية، مهما بقيّت مشتّتة، وبالتالي انعكس على ثقتهم النضالية الحديثة. وما تقولُه هذه الورقة هو أنّ الوعي الحداثي الذي يطبع الربيع الأمازيغي هو وعي يحاول إعادة الجسر بين هذه التفرّقات التاريخية ويتخيّلها على أنّها ذات أصلٍ واحِد. إلاّ أنّ لهذه التواريخ دوراً معلوماً. وربما يعودُ نبوغ الهوية الأمازيغية في الجزائر أكثر من المغرب (مع أن أمازيغ المغرب أكثر من أمازيغ الجزائر) إلى تاريخ العزل الجغرافي والسياسي للأمازيغ في منطقة “القبائل الكبرى والصغرى” و”تل الأطلس” عموماً. فالتيمارات العثمانية لم تقم بشكل واسع في الجزائر، وقد فشلت في ربط المزارع الأمازيغي بالإقطاعي العربي أو التركي. وقد ظلّ بربر “القبائل”، المتحصنين في منطقة “القبائل الكبرى”، وهي المنطقة الجبلية ما بين الجزائر العاصمة و”بجاية”، ومنطقة “القبائل الصغرى”، ما بين “بجاية” و”عنابة”، وفي “جبال الأوراس”، جنوب “قسنطينة” في صراع وثورات دائمة على النظام الإقطاعي العثماني، ما أدّى إلى تقلُّصِ المساحة الأمازيغية وتحصُّنُ البربر في المناطق الجبلية، واكتفائهم بالمساحات والسهول والأودية في تلك الجبال ليقتاتوا على الزراعة.
وفي المغرب قامت ثنائية شبيهة بثنائية السهول والجبال هذه عَرفها الحس الشعبي بثنائية “بلاد المخزن” و”بلاد السيبة”. ورغم رفض المؤرخين اللاحقين لهذه الثنائيات لما تستغفله من أنماط التعاون والتداخل بين “المخزن” و”الريف” (وفي الحقيقة فإن سلاطين المغرب العلويين اعتمدوا في بقائهم على عناصر مُجنّدة من “البلاد السائبة”، وقد فُسِّرّت ثورة الرِّيف في 1920 في إطار ردِّ فعل مجال “السيبة” على نزعِ غطائه “المخزني” ورغبتِه في هذا الغطاء: لنفكر مثلاً في تجارب موحا الزياني وموحا أوسعيد) إلاّ أن هذه الثنائية، غير المؤشكلة في الوعي الشعبي، كانت خطاباً ينتج ممارسات سلطوية معينة. ولا شكّ أنها تُخاطب انكفاء القبائل الأمازيغيّة بعيداً عن المجال المخزني. وقد صارت هذه الأسطورة أساسية للاستعمار الفرنسي لفصل سياسة المجال العربي عن مجال البربر، وهو ما سيعرفُ في التقاليد الاستعماريّة بـ”سياسة البربر” (La politique berbere) وسيتطوّر بشكل درامي إلى “الظهير البربري” في 1930. ورغم أن هذا التمايز لم يقم ابتداءً في الجزائر (بل في المقابل بدأ الاستعمار الفرنسي بسياسة تعريب في “الشاوية” ودافع الحاكم العام في الجزائر عن “قرأنة البربر” (coraniser les berber) إلاّ أنّه كان لهذا الانكفاء بعده الأمني الجغرافي، إذ حُصِرت الهوية البربرية المتحصنة في نفس امتداد الجبال الأطلس التي تحصّن في شعابها بربر الجزائر. وهكذا بقي “الأطلس الكبير” والصغير والمتوسط إطاراً حامياً لهويات البربر.
وربما لغياب هذا العامل الجبلي الوعر لم تُفلِح الهوية، وخصوصاً اللغة الصنهاجية، في الانكفاء بعيداً عن “الفتح العربي” في موريتانيا. وفي الحقيقة فإن الرحالة والتاجر البرتغالي فرناندس، الذي زار المجال الموريتاني في مطلع القرن السابع عشر، يُخبِرُنا عنما يبدو مرحلة أخيرة من صراع “العرب” و”البربر” يبدو فيها أن البربر الآزناكَة أو صنهاجة (الذين لم يشأ فرناندس، وما كان له، أن يُميِّزَ بينهما) تحصّنوا بهضاب آدرار، وما يعرفُ منها الآن بـ”كدية الجل” وربما قروسطياً بـ “جبل البافور”. وهكذا سمح غياب جبال رفيعة ووعرة على المُهاجِم والصائل كجبال الأطلس بما اعتبره المؤرخ آي أيتش نوريس، وإن بدرامية ومبالغة، سحقاً من العرب للبربر.[15] وفي الحقيقة فإنّه بعكس ما في شمال المغرب العربي فإن صنهاجة الصحراء الموريتانية تعرّبوا وصاروا، بحكمّ تحوُّلِهم إلى طبقة علمية، أقدر على استلهام العروبة حتى من مُعرِّبيهم وقاهريهم بني حسّان. وعندما تلوحُ ثنائية “حسان” و”الزوايا” الصّنهاجيين اليوم في موريتانيا فإنّها تخلو من الإحالات اللسانية والعرقية. بل وإذا كان من ثنائيّة في هذا الإطار فهي ثنائية “صنهاجة” و”آزناكَة”، الأمازيغيتان بالأصل. وبعكس المماهاة التي يقوم بها المؤرِّخون الغربيون بين هذين، وهي قطعاً مستقيمة من ناحية الأصل اللساني والعرقي، إلاّ أن “الآزناكَية” صارت ترجمة لفشل بعض الصنهاجيين في تسلًّقِ مقامات التعريب، والبقاء خارج المجال العلمي الصنهاجي مما شرّعَ إلحاقهم وتغريمهم من قبل بني حسّان وبيعِ حقوقهم أحياناً حتى لبني عمومتِهم الصنهاجيين.[16]
4- الوضع الطبقي والإنتاجي
القول النافِل هو أن الاستعمار دخلَ في حالة استقطابية كهذه، إلاّ أنّها صورة يمكن تفكيكها ببساطة. بيد أنّ ما يهمنا هنا هو كيف انفتحَ بهذا المقدم البابُ للتحولات المعيارية في هوية البربر من أقوامية جبالية زراعية إلى عُمالية وبرجوازية. ولا يتعلّقُ هذا فقط بالحدث السياسي المتمثِّلِ في الاستعمار في حدِّ ذاتِه، بل بإعادة ترتيب اقتصاد البحر الأبيض المتوسط في علاقات جديدة منذ القرن التاسع عشر. وخلافاً للصورة النمطية التي تسردها القومية العربية التقليديّة فإن ظهور قضية البربر لا يأتي بصفتِه إدخالَ الاستعمار لجماعات مضطهدة في التاريخ، بل بصناعة تاريخ موحّدٍ للرقعة الجغرافية الواحدة من خلال أواصر السوق المشترك والعلاقات الانتاجية وترابطاتِها الثقافية العابرة، وغالباً المُتحدِيّة، للقبيلة والعرق. وبطبيعة الحال فإن جزءاً من هذه التحولات هو مقاومة التحوُّلات نفسها. فواضح أن الأقليات المغاربية، عكس بعضِ، وليسَ كلًّ، الأقليات في الهند مثلاً، حاربت الاستعمار كثيراً بفعل الإمكانات التي أتاحاها الاستعمار في فتح علاقات نفوذ جديدة للأقليات مع الامبراطورية. ولعلّ ثورة الأمازيغ في 1871 في الجزائر كانت مبتدأ هذه الثورات. وفي المغرب ستظهر مقاومة الاستعمار في الريف البربري في ثورة الريف الأولى في 1909 ثم في كفاح عبد الكريم الخطابي وثورته في 1920 (وإنْ كان الأسلم عدم قراءة هذه الحراكات أنّها حِراكات قومية أمازيغية، مع أن مشكِّليها كان أمازيغاً غالباً).
وغالباً ما يتجاهلُ التأريخ السائد ثورة 1871 في منطقة القبائل الكبرى مع أنّه كان لمترتباتها انعكاس كبير على تغيير مصائر “البربر”، ذلك أنّ انتصار التفوق العسكري الفرنسي على انتفاضة منطقة “القبايل” نجمَ عن إجراءات عقابية تمثلّت، من بين أشياء أخرى، في مصادرة الأراضي الزراعية في منطقة القبايل. وهكذا تدمّرَ الأساس الإنتاجي والزراعي للمجتمعات القبايلية الأمازيغية، فانكسر الانعزال الأمازيغي في الجبال وتحوّلَ مزارعو “تيزي وزو” و”عنابة” إلى يدٍ عاملة في السهول العربية/الفرنسية. وكان لكارثة مجاعة الكروم الزراعية في فرنسا في ثمانينيات القرن التاسع عشر (حيث أدّى وباء الكروم الفرنسية المنتشر بفعل حشرة المن إلى إتلاف نصف محاصيل العنب الفرنسية ما أدّى إلى انخفاض مداخيل الزراعة وهبوط أجور المزارعين وشجّع استقبال المزارعين منخفضي الأجور في عبر المتوسط) انعكاسات هائلة على مزارعي “القبايل” الذين امتصتهم الحاجية الفرنسية للشغيلة الزراعية ووجدوا لأنفسهم مصادر دخل عُمالية من خارج الجزائر. وهكذا تكوّنت أولى النخب العابرة للبحر الأبيض المتوسط في الجزائر. ولدى عودة هذه المجموعات إلى “القبايل الكبرى” سرعان ما تحوّلت إلى طبقة وسطى مُلحقة بالبرجوازية الأوروبية وخلقت فضاءها العام والوطني المكوّن من المدارس الحديثة والصالونات الثقافية والصحف وارتفعت نسب تمدرسها بما زاد على أي منطقة جزائرية أخرى وتصدّرت البيروقراطية الاستعمارية (وإن كانت ستواجه منافسة شديدة من قِبل المستوطِنين الفرنسيين).[17]
وهكذا بدأت القضية الأمازيغية قضيّة وطنية قبل أن تكون قضية أمازيغية، وذلك من منظورين: الأول هو تحول النخب الأمازيغية إلى طبقة وسطى تجارية وإدارية وعُمالية متفرقة في الجزائر، وليست منكمشة جغرافياً أو ثقافياً. أما الثاني فهو تصارع هذه الطبقة مع منع المستعمر لها من تحقيق كلِّ إمكانيتها. وهكذا، للمفارقة، فإن النشطاء الأمازيغيين الأوائل استخدموا خطاب التعريب، وليس القومية الأمازيغية، شعاراً لحربهم ضدّ المستعمر الفرنسي. وكانت حركة التعريب قويّة في أوساطِ أمازيغ وإباضيي “مْزاب” حيثَ بزغّ شاعّر الجزائر، مفدي زكرياء. وكان قادة المقاومة الجزائرية الأمازيغيين قادة تعريبيين في لغاتِهم وتكوينهم أمثال مصطفى بن بلعيد وديدوش مراد ومحيي الدين بكوش وأحمد نواورة تكريم بلقاسم عريبيين. وفي الحقيقة فقد كان من مطالب “البيان الأمازيغي” في مطلع مارس 2000 الاعتراف بالهوية الأمازيغية للأبطال التاريخيين الذين “يسرقهم الخطاب العروبي” أمثال الجزولي وابن مطيع وأجروم والحسن اليوسي.
ويعودُ السبب في هذا إلى كون العربية الفُصحى، التي دّيّنها وعزَلها العصر العثماني، بدأت تتعلمن في هذه الفترة بشمل أكثر وضوحاً، ولم تعد مجرد لغة دينية جامِعة لغير العرب، بل صارت لغة أممية، تقودُها نواة برجوازية قوميّة، تنقل مشاعر الملايين وتربطهم وتُطوِّر قاموسها الحكامي والإداري الحداثي. وهكذا نُلاحِظُ تصاعد المد الثوري في أوساط أمازيغ عنابة وتيزي وزو، وفي جبال الأوراس عموماً، معقل مصطفى بن بلعيد، الشاوي، وأحد القادة الستة بجبهة التحرير الذي حارب الاستعمار في باتنة وعموم الأوراس. وفي المغرب لم تكن القصة بعيدة عن هذا، ذلك أن النخب الثورية في جبال الريف بدأت صعودها الاجتماعي “الحداثي” في إطار استخدامات اللغة العربية والإسبانية. وقد بدأ عبد الكريم الخطابي نفسه صحفياً ومترجماً وفقيهاً وقاضياً تخرجَ من التعليم العربي من جامعة “القرويين”، وكان له تعاطف مع حركات التحرر العربية والشيوعية الأمميّة.[18]
5- الأبعاد الجديدة للقضية الأمازيغية: توسيع ومجانسة الهوية/اللغة
وبالعودة إلى الهوية الأمازيغية الحداثية فلا يبدو أن الحركة الأمازيغية تخرجُ من “المجال الوطني” الذي دخل فيه الجميع غداة الاحتكاك بالاستعمار. غير أن حسم الاستقلال الوطني وتحرير الأمازيغ من ربق الجبال، إضافة إلى صعود المطالب الهوياتية المترافقة مع العولمة قد فتحَ المجال لمرحلة جديدة من الحِراك الأمازيغي، وهي تعريفهُ أمازيغياً وثقافياً، وتكميل الاستقلال العام بالخصوصية داخل هذا الاستقلال. وكما أسلفنا فإن هذه العملية تزداد بتخيل مجتمع أمازيغي تُوحِدُّه اللغة الأمازيغية وتُصبِحُ معيارَه. وربما ليس هذا استثناءً من أي ثقافة قومية تريد مجانسة أفرادِها وتطليس الفوارق اللسانية بين مكوناتِها.
بيدَ أن من صعوبات هذه المجانسة أن شعوب البربر في المنطقة غير قادرة على التواصل بينها بلغة موحدة، ذلك أن التمازيغت المحكية في الأطلس تختلف جذرياً عن التاشلحيت المحكية في جبال الريف. وتختلف الشاوية المحكية في جبال الأوراس جذرياً عن التريفيت التي، وإن كانت تتداخل في نقاط الاحتكاك مع التاشلحيت إلاّ أنها تختلف عنها، ولا يقدرُ أهلها أن يفهموا اللغات الأمازيغية في جبل نفوسة أو منطقة القبائل، دع عنك المزابية أو التماشق المحكية في منطقة “كِلْ آدرار” (جبال الإيفوغاس) شمال مالي أو الغدامسية المحكية في ليبيا. وقد دأبَ دارسوا اللغات الأمازيغية على التمييز فيما بينها بين عائلتين عريضتين غير قادرتين على التواصل بينهما هما الزناتية التي تجمع اللغات المحمية في “جبال الريف” و”الأطلس المتوسط” و”الأوراس” و”جربة” و”جبل نفوسة” في مقابل العائلة الصنهاجية المصمودية المحكية في منطقة القبائل والأطلس الكبير والصحراء الكبرى.[19] بيد أن عدم القابلية للتفاهم هذا يتواصل حتى داخل “العائلة” اللسانية الواحدة فالتاشلحيت تختلف جذرياً عن الزناكَية المحكية بقلّة قليلة في موريتانيا ويختلف هؤلاء عن التماشق، رغم أن كلّ هذه لغات صنهاجية.
ومن الأجدى النظر إلى التقاطعات اللغوية على ضوء انقطاع وتلاحم التقاليد والتواصل؛ ففي المغرب توجد مشتركات لغوية على أسس جغرافية، بَيدَ أنها سرعان ما تفقد الترابط اللغوي بسبب التنافر الجغرافي. فمثلاً يتفاهم سكان جنوب المنطقة الريفية مع سكان شمال المنطقة الأطلسية، أي أن بعض ناطقي التريفية قادرون على التواصل مع بعض ناطقي التامازيغت في منطقة الاحتكاك بينهما. ولكن ناطقي التريفيت غير قادرين على التفاهم مع ناطقي التشلحيت في مناطق التنافر وعدم الاحتكاك. وحتّى هنا لا بدّ من تلطيف هذا الحكم إذ أنّ التصانهاجيت المحكية في الريف المغربي تختلف جذرياً عن بقية الأمازيغية الريفية، رغم تقاربهما الجغرافي والعائلي.[20] وعموماً لا تَقدِرُ الفصائل الاجتماعية الأمازيغية أن تتواصل بينها كلياً بدون استدعاء لغة ثالثة هي العربية أو الفرنسية.
تقومُ الحركة الأمازيغية، باعتبارها حركة طبقة وسطى، على تغميض هذه الفروقات لأن هذا التّغميض يُولِّدُ مجالاً لسانياً مُتخيّلاً يُدمِجُ كافة مكونات الطبقة الوسطية الأمازيغية المغاربية في تاريخ ووقتانية ووجدان واحد. وفي الحقيقة فإن عملية التوحيد اللساني للأمازيغ ليست مجرد رومانسية قومية بل هي عملية سياسية حيوية (المفهوم الفوكوي) استثمرت فيها الدولة في المغرب، رغم شكوى المناضلين الثقافيين الأمازيغ من فقر برامج دعم الثقافة الأمازيغية، إذ يقوم “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” المؤسس منذ 2001 بمشروع توحيد لغة “فصحى” جامعة لكل الناطقين الأمازيغ وجعلها لغة مشتركة لكل دارسي الثقافة الأمازيغية، وحتى المستعمين لها عبر الراديو، جاعلاً بذلك من المدارس والإذاعات الأمازيغية مكاناً لصهر الاختلافات اللسانية بين مكونات “الشعب” الأمازيغي، بل وإدراكه أنّه شعب واحد. ولا يندُرُ أحيانا أن يُعارِضَ مناضلون أمازيغ هذا التقعيد لما فيه من طمسٍ للثراء الثقافي الأمازيغي وتحكم من “الدولة العربية” في الهوية الأمازيغية. ويبزُغُ من معارضي هذا التوجه الأكاديميان الأمازيغيان الجزائري سالم شاكر[21] والمغربي شريف أدركاك.[22]
إن هذا التصور المتجانس لشعوب البربر أنّها أمّة واحدة، وهو للمفارقة نفس إدراك الأخرنة العربية التاريخية للبربر، هو ما يسمحُ للحركة الثقافية الأمازيغية بتمديد مجال هوية الأمازيغ وتوحيدها. ففي الجزائر مثلاً تنافِحُ الحركة القبايلية عن المجموعات الأمازيغية في الجنوب في “مْزاب” وجنوب “وهران” حيثُ تحكي الأقليات الأمازيغية لهجات “التمزابيت” والتنزانيت المختلفتيْن عن التمازيغت. وفي ليبيا يُدخِلُ أمازيغ جبل “نفوسة” الآن في مطالبهم دعوات الخصوصية الثقافية لقبائل التبو جنوب البلاد، رغم أنّ هؤلاء غير قادرين على التواصل معهم إلاّ بالدارجة العربية الليبية، ورغم تفردِّهم السياسي عنهم. ويحدثُ نفس الشيء عندما يقومُ أمازيغ الشمال بالإحالات الخطابية إلى وضعية الأمازيغ في موريتانيا، رغم أنّه لم يعد يوجد في موريتانيا غير2001 ناطق باللغة الصنهاجية[23] ولم ينتظموا بعدُ في حركة تُسيِّسُ هويتهم اللسانية وتُوسِّعُها إلى مطالب ثقافيّة وسياسية. وباستثناء الإحالات، القدحية أحياناً، إلى “الأقلية العربية البربرية” التي هي من القاموس السياسي اليومي لحركة “إيرا” الانعتاقية،[24] إضافة إلى محاولات شبه منسية من حركة “ضمير ومقاومة” الراديكالية في التسعينيات إعادة الهوية “الصنهاجية” إلى الخطاب السياسي من منظور تفكيك المركزية البيضانية، فإن الوعي السياسي الموريتاني المعاصِر لا يَعقِلُ حركة أمازيغية، ويبدو له المصطلح إشكالياً، إن لم يكن غامضاً.
6- البعد الثقافي
وبقدر ما يجانس الخطاب الأمازيغي المركزي اليوم الهويات الجغرافية والتاريخية المتنافرة للبربر فبقدر ما تقوم “صناعة الثقافة” الأمازيغية بصناعة تقاليد يتمُّ تصورها أساساً وجوهراً لروح الشعب الأمازيغي، وخصوصاً في المغرب. وهنا يتم التركيز على الروزمانة الأمازيغية وتوسيعها إلى أساس للتاريخ وللوقتانية الأمازيغيّة. ولذا صارَ في السنوات الأخير رأس السنة البربرية، يناير، فرصة احتفائية وخصامية بخصوص الهوية الأمازيغية.[25] وبنفس الطريقة يتم التخصيص على خط التيفيناغ كرمز للحقوق السياسية الأمازيغية. ورغم أن التاشلحيت ظلّت تُكتبُ بالأحرف العربية إلى عهد قريب وأن الأمازيغية المغاربية، بعكس الطارقية، انقطعت عن التعبير بالتيفيناغ منذ قرون إلاّ المنعرج الهوياتي الاستقلالي، سواء على مستوى بعضِ الحقوقيين الأمازيغ أو المؤسسات المغربيّة، ينزع إلى تفريد اللغات “الأمازيغية” بالتيفيناغ التي ازدهرت في المجال الطارقي جنوب الصحراء الكبرى أكثر من ازدهارِها في المغرب؛ وصارت أساسَ مشروع الدولة المغربية لتقعيد الكتابة باللغات الأمازيغية وفكِّ الارتباطِ بينها وبين العربية. وفي مرحلة معينة حرّمت الحكومات المغاربية رفع الشعارات الأمازيغية سياسياً قبل أن تتراجع عن هذا في “الربيع الأمازيغي”. وبرغم معارضة مثقفين أمازيغ كسالم شاكر لهذا التقعيد، لأنّه يقطع التواصل بين أمازيغ الجزائر الذين يكتبون لغتهم بالخط اللاتيني وبين أمازيغ المغرب الذين يكتبون بالتيفيناغ، إلاّ أن الحكومة المغربية تحقِّقُ نجاحاتٍ في مثاقفة التيفيناغ وتعميمه في المرافق الإدارية (وإن ليس في بقية المرافق العمومية).
ويظهر في الإحيائية الثقافية الامازيغية تعميم عادات “يوم نفقة اللحم” و”توزيع الرمان” والبحث عن أسماء “أمازيغية” متمايزة عن الأسماء العربية. وكانت الملكية المغربية، التي تمتلك تاريخاً في تقنين الأسماء (مثلاً ليس من حقِّ عائلة غير علوية التسمي أو التكني بالأسماء العلوية) قد حرّمت “الأسماء الأمازيغية” إلى أن شرّعتها مؤخراً. ويترجم هذا القرار انتصاراً للهوية الأمازيغية. ولا شكّ أن الفنانين الأمازيغ الجزائريين، الذين يشكِّلون حالة من التواصل الثقافي مع المغرب، قد سيّسوا التسميات الأمازيغية عن طريق إذاعة الكلمات والأسماء الأمازيغية كما هو شأن الفنانين الجزائريين تاكفاريناس وعميروش إغونام ومركوندة وماسينيسيا علي شيبان، الذين غالباً ما يعيدون أسماء الأبطال التاريخيين للأمازيغ إلى الاستخدامات والمسميات اليومية. ومن الطريف أن جزءً من الاحتدام بين الأمازيغ في “تيزي وزو” وبين الحكومة الجزائرية في 2001 كان يتعلّقُ بتنازعٍ على تسمية ناشطٍ أمازيغي قال المناضلون الأمازيغ أن اسمه ماسينيسا قرماح، وهو اسم يُحيل إلى الملك ماسينيسا البربري، وقالت الحكومة أن اسمه كريم، وهو اسم يُخفي الهوية الأمازيغية.
7- قضية علمانية؟
يرى الباحث بول سلفرستين أن من الأساطير المؤسِّسة للحراك الأمازيغي هي فكرة الإسلام المعلمن لدى الأمازيغ في مقابل الإسلام السلفي الحرفي لدى العرب،[26] مُشيراً إلى مصادرات تقوم بها عناصر في الثقافة الأمازيغية المعاصرة للاحتفاء بعناصر ثقافة البربر مما قبل الإسلام وإلى خصوبتها الوثنية والمسيحية واليهودية، وإلى مصادرة صناعة الثقافة الأمازيغية الحديثة للإسلام في نقلها لصورة البربر المعاصرين.[27] وكان لظهور صناعة الثقافة الأمازيغية وموضعتها انعكاسات على النقاش الحاضر الغائب أبداً في الطيفية الحداثية المغاربية بخصوص العلمانيّة والدين، وخصوصاً مع صعود خطاب إسلاموي أراد بدوره ترسيم العادات والثقافات لتنضوي تحت إطار الأرثودوكسية. وفيما يُهاجِمُ هذا الخطاب الأرثودوكسي المغاربي الممارسات الدينية غير السائدة فإنه يصطدم مع الخيارات الدينية التاريخية للبربر. وهكذا يجد الخوارج الإباضيون في منطقة مزاب في الجزائر نفسهم في مواجهة خطابٍ تخويني وتجريمي يصل أحياناً إلى عداء شعبي. ولعلّ أحداث “الغرداية” التي تواجه فيها الإباضيون الأمازيغ مع المالكيين العرب جنوب الجزائر في 2004 و2014 فاقمت هذا الاحتدام.[28] وبالنسبة للحركة الأمازيغية فإن هذه معاداة للأمازيغ تستدعي التضامن القومي. ولا يغيب عن الحركات العلمانية في العالم العربي هذا البعد الاحتدامي بين الإسلاموية والأمازيغية حيث في تونس وجدت الأحزاب العلمانية في دعم الحراك الثقافي الأمازيغي في تونس فرصة سياسية ضدّ الإسلام السياسي الذي تمثلُّه حركة النهضة.[29] وقد وجدَ الكثيرون في الاحتدام الثقافي الذي يُميِّزُ أقطاب التفكير في المغرب (مثلاً محمد أركون على حدة في مقابل طه عبد الرحمن والجابري وعبد السلام ياسين وغيرهم على حدة أخرى) استقطاباً بين مُحَابين ومُعَادين للأمازيغية.[30] ولاشكّ أن أسطورة لا إسلامية البربر وطّدت الخلافات بين الحركة الأمازيغية المغربية وحركات الإسلام السياسي، بحيثُ أن الناشطين الأمازيغ في حركة 20 فبراير 2011 التي تصدّرت حركة الحجاج الشعبي في المغرب غداة الربيع العربي قد انسحبت من الاحتجاجات بسبب التحاق الإسلاميين بها. [31]
بطبيعة الحال ليست الحالة استقطابيّة دوماً بين الأمازيغ والإسلاميين. ففي المغرب ساهمَ حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية” الذي قاده عبد الكريم الخطيب، والذي انحدر من كفاح الريف المغربي وساهم نشاطه في بلورة حركة سياسية سرعان ما صارَ لها بعدٌ أمازيغي هي “الحركة الشعبية” في إدخال “حركة التجديد” التي سيتفرع منها حزب “العدالة والتنمية الإسلامي” في السياسة. وفي ليبيا شهد عام 2013 تحولاً مفرقياً عندما تخلت الحركة السياسية الأمازيغية في “جبل نفوسة” عن حلفها مع ثوار الزّنتان غداة انضمامهم للواء حفتر، وتحالفوا مع الإسلاميين الذين استقلّوا بطرابلس.[32] بيدَ أن استقطاباً يحدث على المستوى الخطابي، فمثلاً يتعادى الخطاب الدعوي الإسلامي، الذي يرفض الوشم، مع عادات توشيم الوجه التي هي جزءٌ من التقاليد الأمازيغية في المغرب. ويحدثُ توترٌ كهذا على مستوى العادات الزفافية المُتعيّة، ذات الأصول البربرية، والتي بُعثَت من جديد في إطار صناعة الثقافة المغربية وفي إطار ما رآه بعض الباحثين مشروعَ “نزع السياسية” من قبل الملكية المغربية أيام الحسن الثاني. وليس بعيداً من هذا تصور وإدراك الممارسات الرقصية، المزدهرة في منطقة الأطلس المتوسط التي، في نفس الوقت الذي تكتسب فيه شرعية باعتبارها تقاليد أمازيغية، فإنّها تواجه تنخيساً وتقريعاً في الخطاب الدعوي الإسلامي.[33]
الهوامش:
[1] بخصوص توصفة “الربيع العربي” وأن مُطلِقَها هو صحفيُ “فورين بوليسي” مارك لينتش انظرالرابط.
[2] لم يكن غريباً في عزِّ “الرّبيع العربي” أن رأى الكثيرون علاقة بينه وبين حركات المدّ الشعبي اللاحق حتى في الغرب وفي أميركا كحركة “احتلوا وول ستريت” الاحتجاجية في أميركا. انظر مثلاً مقال مايكل سابا (حركة الربيع العربي ألهمت محتجي وول ستريت) على “سي أن أن” بتاريخ سبتمبر، 2011: انظر الرابط.
[3] في التأريخ النقدي لمصطلح “الربيع” وارتباطه بعواطف ليبرالية امبريالية معينة انظر مقال جوزيف مسعد: انظر الرابط.
[4] عن الوضع في ليبيا وانبثاق الهويات لدى الأمازيغ والتيبو والطوارق، انظر: إينس كول
“الأقليّات الرئيسيّة” في ليبيا: البربر والطوارق والتيبو: سرديات متعدِّدة للمواطنة واللغة وضبط الحدود:
Ines Kohl, 2014, “Libya’s ‘Major Minorities’. Berber, Tuareg and Tebu: Multiple Narratives of Citizenship, Language and Border Control,” Middle East Critique, 23: 4, 423-438.
[5] موقع الجزيرة. جمعية للثقافة الأمازيغية بتونس. بتاريخ 31، 7، 2011. انظر الرابط.
[6] انظر مثلاً:
أحمد جدو، كيف اختفى أمازيغ موريتانيا؟، موقِع رصيف، 18، 08، 2015. انظر الرابط.
محرز مرابط، هل تخلّى أمازيغ موريتانيا عن جذورهم: القصة الكامِلة، أصوات مغاربية، 31-07-2017 انظر الرابط.
[7] بروس مادي وايتزمان، (هل هو منعطف؟ الربيع العربي والحركة الأمازيغية)
Bruce Maddy-Weitzman, “A Turning Point? The Arab Spring and the Amazigh Movement,” Ethnic and Racial Studies, April, 2015, pp. 2499-2515.
[8] كنتُ قد حلّلتُ تقلقل الأوضاع في مالي في 2013 في مقال منشور بتاريخ 10 فبراير 2013. أبو العباس ابرهام. رجال ودول ومشاريع. موقع تقدمي. رابط موازي: انظرالرابط.
[9] سأستخدمُ طوال هذا المقال تبادلاً بين مفهومي “البربر” و”الأمازيغ” ليس رفضاً للباقة السياسية أو إنكاراً لرفض النشطاء الأمازيغ لمفهوم “البربر”، بل رغبة في إحقاق ثنائية بين وضعية كانت فيها الهوية الأمازيغية مفهومة غيرياً وأخرى مفهومة ذاتياً. فالبربر هنا هي الوضعية التاريخية لشعوب تحت نظرة الآخر، الفاتح، القاهر. هي هنا هوية لاكانية تخلُقُها صورة المرآة. أما “الأمازيغ” “الرجال الأحرار” فهي مرحلة االقومية الأمازيغية وصنع ذاتِها بذاتها. إنّني إذاً أميّز بين البربر كشعب ما قبل حداثي وبين الأمازيغ كشعب حداثي.
[10] بنديكت أندرسون، المجتمعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها. تحقيق ثائر ديب. دار قدمس للتوزيع والنشر،2009.
[11] Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
[12] انظر خبر ثورة البربر على العرب عام 117 هـ برواية ابن الأثير:
أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية، لبنان: بيروت، ج4، ص 416-418.
[13] عن هذه الدول انظر الأعمال الأساسية، كما هي موجودة مثلاً في أعمال البكري وابن حوقل والإدريسي والمؤلِّف المراكشي المجهول لكتاب الاستبصار وعبد الوهاب التميمي المراكشي وابن عِذارى وابن تومرت وابن أبي زرع، الخ. ولعلّ أفضل الأعمال التحريرية الجامِعة لهؤلاء هو مثلاً كتاب: نخب تأريخيّة جامعة لأخبار المغرب، نشر ليفي بروفنسال، باريس: مطبوعات لاروز، 1948.
محمود إسماعيل عبد الرازِق، الخوارِج في بلاد المغرب حتّى منتصف القرن الرابع الهِجري، الدار البيضاء: دار الثقافة، 1985. وانظر:
Paul M. Love, Jr « The Sufris of Sijilmasa : toward a history of the Midrarids,” The Journal of North African Studies, (2010) 15: 2, 173-188.
[14] ابن وردان، مستند تاريخ الأغالبة. تحقيق محمد زينهم محمد عزب. القاهرة: مكتبة مدبولي، 1988.
[15]انظر نقدي لهذه السردية في كتابي عن تاريخ موريتانيا، أبو العباس ابرهام، آلاف السنين في الصّحراء: تاريخ موريتانيا من البواكير إلى اليوم. بيروت، لبنان: دار نماء، 2017.
[16] نفسه.
[17] لمقال في المتناول في هذا الإطار انظر:
Yves Lacoste & Camille Lacoste-Dujardi, “La revendication culturelle des Berbères de Grande-Kabylie”, Le Monde Diplomatique, Décembre, 1980, pp. 34-35.
[18] انظر مثلاً:
علي الإدريسي، عبد الكريم الخطابي: التاريخ المحاصر منشورات تفرزان ريف دار النجاح الجديدة، 2007.
[19] انظر مثلاً المقال الكلاسيكي المنشور في 1953 لوالتر كلين:
Walter Cline, “Berber Dialects and Berber Scripts,” Southwestern Journal of Anthropology, 9, 3, pp. 268-276.
[20] شريف أدرداك، “تصنهاجيت” أمازيغية مغايرة لتيريفيت لكنها مفهومة”. جريدة تيدغين، 27 ديسمبر 2013. انظر الرابط.
[21] انظر مثلاً تصور سالم شاكر:
“Salem Chaker à propos du statut de Tamazight. Tamazha.fr. 23 mai 2013. Link.
[22] جريدة الريف، المغرب، 12 سبتمبر 2013. انظر الرابط.
[23] بحسب موقع “أثنوبلوغ” المتخصِّص في اللغات عبر العالم.
[24] “بيرام ولد اعبيدي في جنيف: موريتانيا تحكمها أقلية عربيّة بربرية منذ الاستقلال”. أقلام حرة. 20، 03، 2010 انظر الرابط
[25] كامل الشيرازي، “عيد يناير مناسبة لإحياء التراث الأمازيغي”. يومية إيلاف الإلكترونية. بتاريخ 13 يناير 2009. انظر الرابط.
[26] Paul Silverstein, “The Cultivation of “Culture” in the Moroccan Amazigh Movement,” Review of the Middle East Studies, 43, 2, (winter 2009), pp. 168-177.
[27] نفسه، ص، 173-174.
[28] شبكة الإعلام العربية. “أحداث الغرداية بالجزائر: نزاع طائفي تعود جذوره لأكثر من أربعةِ قرون”. 19 مارس 2014. انظر الرابط.
[29] Bruce Maddy-Weitzman, “A Turning Point? The Arab Spring and the Amazigh Movement,” Ethnic and Racial Studies, April, 2015, p. 2506-2507.
[30] انظر مثلاً
إبراهيم أزروال، “أركون والأمازيغية: في نقد المركزية اللسانية العربية الإسلامية” 2/5. موقع الأوان. بتاريخ 4 نفمبر 2010. انظر الرابط.
[31] Bruce Maddy-Weitzman, pp. 2502-05..
[32] نفسه، 2506.
[33] Bernhard Venema and Jogien Bakker, “A Permissive Zone for Prostitution in the Middle Atlas of Morocco,” Ethnology, Vol. 43, No. 1 (Winter, 2004), pp. 51-64.