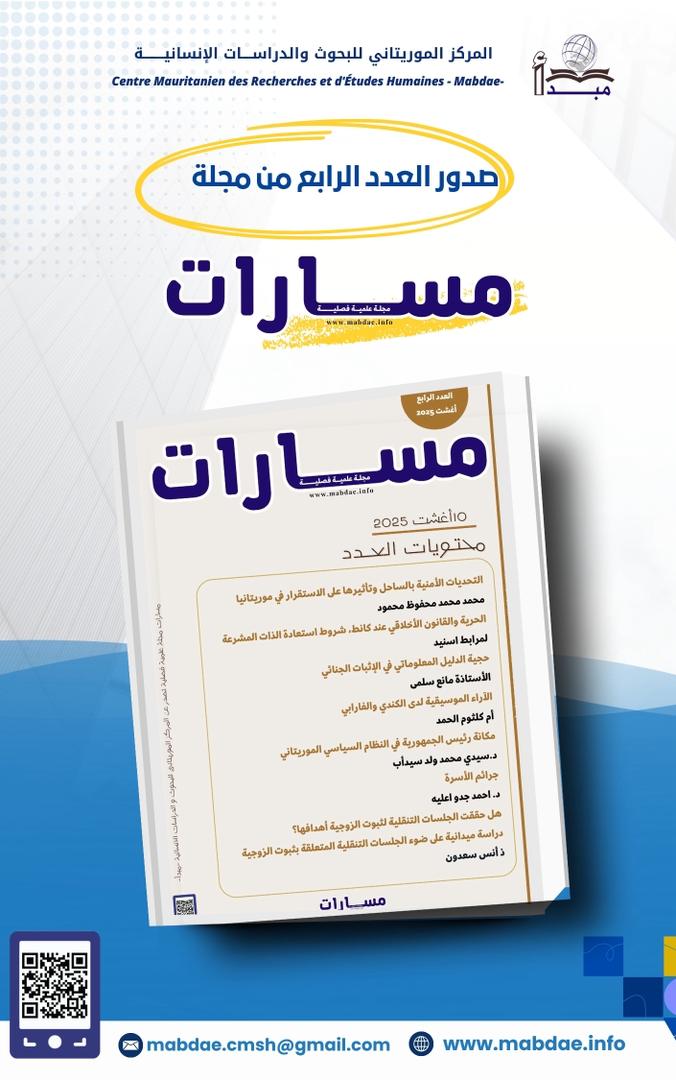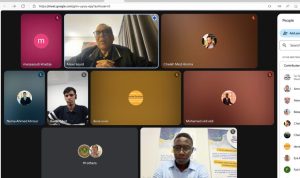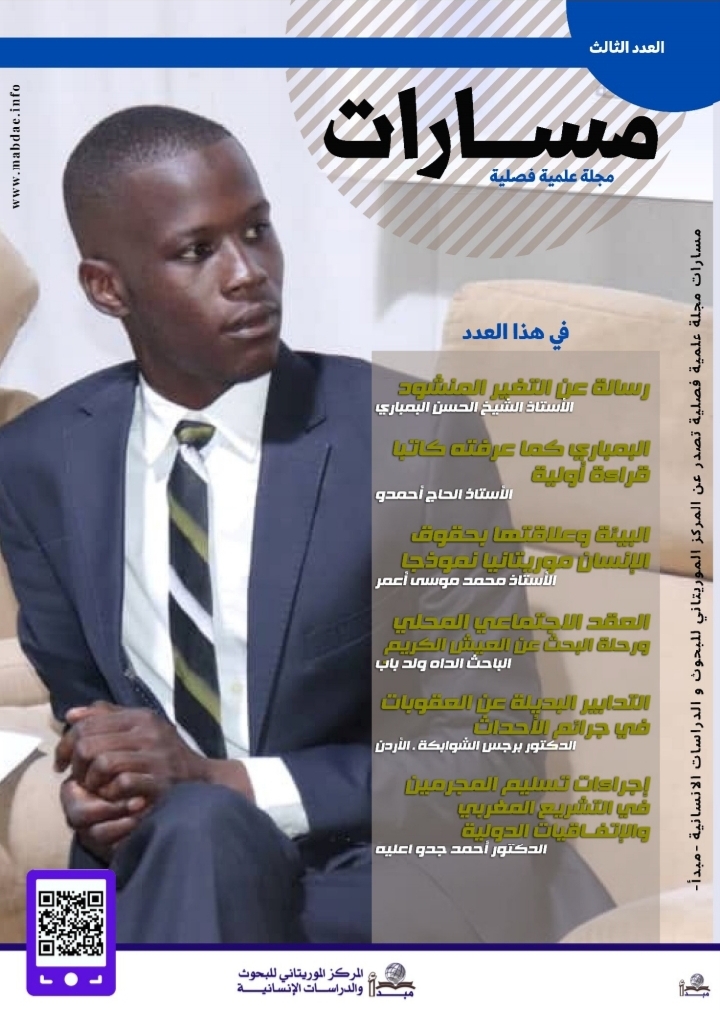تطرح قضية تغلغل الثقافة الفرنسية في الجهاز الإداري الموريتاني إشكالية تتجاوز بعد اللغة لتطال حدود الهوية، ولقد عمل الاستخدام الاجتماعي والسياسي الحالي للمعرفة الاستعمارية مجسدا في اللغة الفرنسية بالإدارة على توتير العلاقة بين الإنسان الموريتاني وذاته والمواطن ودولته والتأسيس لعلاقة قلقة مع الذات والتاريخ.
لقد استعانت الدولة الوطنية في نشأتها أساسا بالمترجمين وعمال الإدارة الفرنسية على قيادة دفة البلاد الجديدة المنبثقة وسط مجتمع تقليدي، وارتبطت الحظوة المعرفية بمدى القرب من المرجعية الفكرية للفرنسيين وتملك الرؤية الثقافية للمستعمر ودرجت الأدبيات الإدارية للفرنسيين على اعتبار علماء الدين الموريتانيين الأجلاء أميين لعدم تحدثهم الفرنسية.
ولم تتمكن الدولة الناشئة من تحقيق القطيعة المطلوبة بين الماضي الاستعماري والحاضر المستقل فبات ينظر إليها كصنيعة استعمارية لتولي المقربين للثقافة الفرنسية زمام قيادتها، وظلت الفرنسية لغة الإدارة بامتياز مع أنها لم تتسلل إلى المحيط الشعبي الذي تغريه الوضعية الاقتصادية وغياب الإرث الدولتي للبلد بالإبقاء على قليل صلة بالإدارة.
ولقد شهد مسار التخلص من عقدة اللغة الفرنسية احتكاكات متعددة اكتسى بعضها لبوسا وطنيا في أحداث 1966 وثوريا في قرارات 1973، وظلت المحاولات المتقطعة للتنصل والانسلاخ من الماضي الثقيل محكومة بسياق اقتصادي ضاغط وتاريخ ملح يقترب من الحاضر.
وعلي الرغم من انقضاء أزيد من نصف قرن على استقلال البلاد فان التوجهات التحررية تجلت أساسا في قرارات ظرفية أو إعلانات مبدئية لا تجد تجذيرا لها في الواقع بفعل العلاقة التاريخية المستبدة مستعمِر/مستعمَر و إكراهات الأنماط المقولبة التي تلصق أحيانا بالعربية من عجز عن مواكبة التطورات وعزلة في السياق .
ويحس المعربون العزلة في وطنهم من حيث فرص النفاذ إلى الوظيفة العمومية والترقي في الجهاز الإداري وسط نصوص نظرية تحتضنهم وواقع عملي يلفظهم في ما يجسد حقيقة الانفصام القائم بين النظرية والتطبيق.
وعلى الرغم من أن قضية التعريب باتت محسومة من الناحية الدستورية باعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية، فإن الإدارة الموريتانية ما زالت عصية على التعريب بإرادة من بعض السياسيين الموريتانيين ودعم من الفرنسيين وفي غياب كامل لأي مبادرة من شأنها ضمان تجاوز الوضع الراهن.
وتأسيسا على ملاحظة انسلاخ النصوص القانونية من محيطها وسعيا إلى ضمان التصالح مع الذات بالترسيم الفعلي للعربية، تستمد التساؤلات التالية وجاهتها وتؤسس لمشروعيتها: هل تكفي الآليات التنظيرية لتمكين الموريتاني من التصالح مع ذاته بتطبيق الترسيم الفعلي للغة العربية وتمكين المعربين من تجاوز عقدة تفوق المعرفة الاستعمارية؟ ما تجليات تلك العقدة وإلى أي حد ساهم النظام الرسمي في تجذيرها بالفعل أو بغياب الفعل؟ وما الآليات الكفيلة بالتخلص من الشعور المستبد بالدونية لدى المعربين تبعا لمساءلة النظام الإداري المعمول به وأملا في تعزيز الآليات الذاتية والموضوعية.
تأصيل:
“ظهر إسم موريتانيا لأول مرة في وثيقة للوزارة الكولونيالية الفرنسية في دجمبر 1899 وذلك أثناء تشييد المستعمر الفرنسي لقواعده في السنغال”2، وقد عرفت هذه المنطقة عدة مسميات اعتمد بعضها على معايير غير جغرافية لتحديد فضائها الجغرافي مثل العناصر الثقافية وأسلوب الحياة، ومن هذه المسميات : بلاد شنقيط ، أرض الملثمين ، بلاد السيبة ، المنكب البرزخي ، بلاد التكرور ،أرض الرجال.
وتبعا لتعدد زوايا الرؤية والعصور تعددت زوايا معالجة الموضوع من قبل الباحثين بحساب مدى إيلاء الاهتمام حال التعريف للعناصر الثقافية أو السكانية أو السلطوية،
وفي هذا السياق اعتمد المؤرخ الموريتاني المختار ولد حامدن3 على اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ لتحديد وحدة المنطقة التاريخية والبشرية.
و اعتمد الباحث الانجليزي نوريس (Norris) على الخصائص اللغوية والأدبية باعتبارها المميزات الأساسية للشناقطة.
أما تيودور مونو(T. Monod)الذي وضع خريطة للمجموعات الثقافية بالصحراء الكبرى فقد انطلق من تنوع وأشكال رحل الجمل وخلص إلى أن ميزات الشناقطة يصعب تحديد أصولها كما عمد باحثون آخرون إلى معيار اللهجة الحسا نية لتحديد المجال الجغرافي.
وعلى المستوى الإداري لم تعرف المنطقة قيام سلطة مركزية توحد كل أطرافها وسكانها المتصلين في أرجائها كما لم تخضع لحكم سلالة بشرية أو ثقافية أو حضارية واحدة.
ومنذ قيام دولة المرابطين في القرن الخامس الهجرى (426 – 441 هـ) ظلت المنطقة بدون سلطان مركزي قبل أن يخضعها الفرنسيون لاستعمارهم بداية القرن الـ20.
“ومع ذلك فقد ظل التاريخ السياسي القريب لموريتانيا وثيق الصلة بالتحولات الكبرى التي مرت بها المنطقة الشمالية لإفريقيا، رغم ما يميزه من سمات خصوصية أبرزها دينامية نشوء الكيان السياسي الموريتاني في ظرفية تحكمها إحداثيات زمانية ومكانية تنضح بمؤشرات وضع داخلي متأزم و إرادة استعمارية مترددة وحركية استقطاب إقليمي مزدوج”4
و كان من الواضح كما تبين الأدبيات الاستعمارية ضرورة وجود منطقة عازلة بين الفضائين العربي المتوسطي والإفريقي للحد من المد الديني والثقافي العربي في تلك الربوع منذ ظهور الدولة المرابطية4، وهو ما سيؤثر لا حقا على المعطي الثقافي بالمنطقة بما فيه مكانة العربية ودورها في تشكل الذات والهوية بموريتانيا.
“وتتشكل الساكنة من أغلبية5 عربية وأقليات زنجية من مجموعات البولار السنونكية والوولف يدينون جميعهم بالإسلام” وشكلت مدارسهم حصنا كبيرا لمقاومة الاختراق الثقافي الغربي وساهم فقهاؤهم في نشر الدين الإسلامي والتمكين للثقافة العربية بإفريقيا.
إن إكراهات النشأة وتنازع النخبة حول هوية الانتماء وحتي مشروعية وجود الكيان الجديد ولدت تذبذبا مشهودا لدي النخبة السياسية الوطنية الحاكمة في رسم المشروع الوطني للدولة الجديدة وتحديد هويتها الثقافية وعلاقتها بالمحيط الإقليمي.
إلا أننا نلمس بصفة جلية في الخطاب السياسي للرئيس الأول المختار ولد داداه وعيا متزايدا بهذه الإشكالية ضمن مشروع بناء “الأمة الموريتانية””إننا أمة تنشأ6، ولدينا الوعي بذلك، فلنبن الأمة الموريتانية،إن موريتانيا هي بالفعل جسر طبيعي وهمزة وصل بين العالم العربي المتوسطي والعالم الإفريقي الأسود”……مع ذلك فهو لا يريد القطيعة مع فرنسا في نفس اللحظات ويشدد على ضرورة الحفاظ على علاقة قوية معها إنه باختصار يدرك كل الأبعاد والتحديات المحيطة به التي تهدد هوية الكيان الناشئ ووحدة ذاته.
إن استقراء تاريخ ونشأة وتطور الدولة الوطنية يعكس بجلاء حقيقة أن إحدى سمات الإشكالية الكبرى التي طرحت على مسار تكوين الكيان السياسي الموريتاني المستقل كانت مسألة الهوية الثقافية السياسية للبلد.
و على الرغم من تجلي الانتماء العربي وعراقه هذا الانتماء إلا أن المشروع الاستعماري الفرنسي مافتئ يعمل على طمس هوية البلد من خلال سياساته الثقافية والترتيبات الاندماجية الإقليمية.
ولقد شكلت الورقة الثقافية إحدى أبرز تجليات الصراع السياسي الداخلي بين المجموعات الموريتانية المختلفة ،فركز التيار القومي العربي ، الذي ترجع جذوره الأولى إلى بوادر نشوء الحركة الوطنية ،على المطالبة بانتهاج التعريب الشامل في مجالات الثقافة والإدارة والأشغال وهو ما سيترتب عليه الأخذ بمبدأ ترسيخ اللغة العربية الذي تبناه مؤتمر حزب الشعب الحاكم المنعقد 1966م الأمر الذي مهد لإرساء إصلاح تربوي يقضي بإلزامية وترسيم اللغة العربية في المدارس الحكومية.
وقد أفضى القرار مع ما يحمله من إرادة في التصالح مع الذات، ولو بالتقسيط،إلى أزمة داخلية عنيفة تمثلت في احتجاج مجموعة تضم تسعة عشر إطارا تنتمي إلى الأقليات الزنجية حيث اعتبرت أن هذا القرار بادرة “للتحكم السلطوي ” ولممارسة هيمنة عرقية وفرض الاستلاب الثقافي على الأقليات ثم تحول الاحتجاج إلي صدامات عنيفة ذهب ضحيتها بعض القتلى والجرحى من الجانبين ورغم احتواء الأزمة بسرعة إلا أنها خلفت جروحا عميقة ستمتد أثارها غضة في المراحل التالية وبالرغم من تكرير الانتماء المزدوج الموريتاني عبر مقولة الأمة المندمجة الغنية بتعددها واختلاف مكوناتها فان كل تلك التأكيدات والخطوات لم توفق عمليا في حسم إشكالية الهوية ومكانة اللغة العربية .
غير أن خط التعريب وتركيز الهوية العربية للبلد قطع خطوات ملموسة بعد انضمام موريتانيا إلي الجامعة العربية عام 1973 واعتماد سياسة الاستقلال الثقافي7 وتدعيم الأصالة التي أدت في ما بعد إلي الإصلاحات التعليمية وتكريس اللغة العربية كلغة عمل و إدارة بعدما كانت الفرنسية لغة العمل بموجب الدستور.
ثم ظهرت في ما بعد حركات قومية 8(عربية الناصريون البعثيون حركة اللجان الثورية ) التي سعت إلى توطيد المكسب وإذكاء البعد العربي في البلاد.
الحسم المؤجل:
لم تحظ إشكالية الهوية وتوابعها بمكانة متقدمة ضمن أولويات الحكام الموريتانيين منذ ظهور الدولة الوطنية وباتت تثار أساسا وفق ردات فعل طارئة أو ردا على مستجد ضاغط ، وظلت البلاد محكومة في الجانب النظري باللغة العربية لغة رسمية وفي الجانب التطبيقي باللغة الفرنسية لغة عمل.
ولقد تسببت المراوحة بين تسييس النظام التربوي تعريبا وفرنسة في خلق جيلين متغايرين يسكنان الأرض ذاتها ويتكلم بعضهم لغات لا تمت إليها ولئن كان من الإنصاف الاعتراف بأن الخطأ لا يتحمله صغار القوميتين الذين كانوا ضحية نظام تربوي غير متوازن فإن الخطيئة تعود بالأساس إلى غياب الوعي الكافي لدى النخب الحاكمة بضرورة إيجاد حسم نهائي لإشكال الهوية وبمتطلبات التمكين للغة العربية وفاء للدستور و للتاريخ و للحاضر والمستقبل.
وفي ظل الانفصام الحاصل بين النظرية والتطبيق باتت المخرجات التربوية بعيدة كل البعد عن متطلبات السوق وعملت المؤسسات التعليمة على تخريج أجيال عاجزة تحمل شهادات غير مطلوبة وخبرات ناقصة وظلت السوق مغلقة أمام المعربين ومفتوحة أمام أقلية تتحدث باللغة الفرنسية تجد ذاتها أكثر حظوة في النفاذ إلى المراتب الإدارية وأقل شعورا بضرورات التصالح مع مكونات الذاتية الثقافية للبلد.
وفي كل عقدين تقريبا كانت الأحداث البسيطة والحوادث العرضية تنذر بانفجار و انشقاق اجتماعي شعاره اللغة ومن ورائه الهوية وكأن الدولة التي ينبغي أن تتفرغ لمعارك التنمية لم تحسم بعد أولوياتها في خيار الهوية بل باتت تؤجل في كل مرة الحسم أو تعمد إلى الطرق على أبواب مفتوحة حسم فيها الدستور منذ ظهور الدولة الوطنية وبات التجسيد العملي يعوزه تطبيق النصوص القانونية.
وفي عامنا هذا تكررت الأحداث ذاتها بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين عن مكانة اللغة وعادت إشكالية اللغة من جديد بقوة بعد تبادل للاتهامات بشأن سعي بعض الأطراف بتصريحاته الهادفة إلى التعريب وتخوف بعض الطلبة الزنوج من فرض إلزامية التعريب بما يترتب على ذلك من إقصاء ممنهج من سوق العمل.
وانبرى القوميون من الفئتين مشجعين أو مستهجنين للقرارات الجديدة وفي كل الحالات تغيب المعالجة العقلانية ويطغي الطابع الاستعراضي الذي لا يسعي لمناقشة كنه الموضوع بقدر ما يهدف إلى الالتفاف عليه بالأساس أو كسب معركة إعلامية تتجدد كل سنتين ويكتفي أصحابها بالتمترس وراء عبارات القهر والإقصاء من جهة أو الانغلاق والعمالة من جهة أخرى.
تجليات مفارقة:
تعيش موريتانيا تناقضا صارخا بين الجانب النظري القاضي بترسيم العربية وفق مقتضيات الدستور وبين الجانب التطبيقي في الترسيم الفعلي للفرنسية.
وتكشف المتابعة الميدانية للحضور الفعلي و القيمي لهذه المعاناة في واقع التداول اليومي والأمثال الشعبية وللتندر والتنكيت ولم تتمكن الدولة الوطنية في مسارها الاستقلالي من التملص من هذه المفارقة في تصوراتها أو ممارساتها فاستسلمت لواقع ضاغط ولم تتملك الشجاعة اللازمة لبدء خطوة الترسيم الفعلي للعربية.
حتى رواد الإصلاحات التربوية الموريتانيين كانوا يرسلون أبناءهم صباحا إلى المراكز الفرنسية لتلقي الدروس وينعشون المحاضرات مساء حول واجب التعريب، كل ذلك إيمانا بأن المستقبل الوظيفي يفرض التعاطي بالفرنسية وتشكيكا بقدرة اللغة العربية على المواكبة أو المنافسة والتي لم تعد تطعم خبزا ولا تفتح آفاق عمل بالمفهوم البراغماتي الخالص.
لقد ساهمت عوامل متعددة في تعزيز هذا الحضور الدائم للفرنسية والإبقاء على اللغة العربية خارج التداول اليومي ومن بينها الارتباط التاريخي العلائقي مستعمر مستعمر وندرة العنصر البشري المتخصص في المجالات الفنية عند تأسيس الدولة وعدم مواكبة النظام التعليمي لمقتضيات التعريب وحرص النخب الجديدة في الدولة على الظهور بمظهر المنفتح الحداثي.
وظلت النظرة الممتهنة لخريجي اللغة العربية في المرفق العمومي من أكبر تجذرات التفرنس بالإدارة الموريتانية ومع هذه تجذر الظاهرة لم يعد تملك الإرادة السياسية لوحده كافيا للقضاء عليها ولا إعلانات الشرف أو المبادئ ما لم تتنزل ضمن مسار عام شجاع وجريء غايته التطابق مع القوانين المنظمة والتصالح مع ذاتية الشعب المسلوبة دون خوف ولا تسييس بتكريس التطبيق الفعلي للغة العربية لغة للادارة الموريتانية.
إن الاختيار، و الحسم بالنسبة للعربية في الواقع نظري، لأنه ليس اختيارا سياسيا وإنما هو حسم حضاري ووجداني. لا أحد يمكنه أن يتجرأ إلى حد أن يدوس تراكم القرون ويحرم ويسب الأجيال القادمة. الاختيار الوحيد الممكن والمعقول، بالنسبة لنظام جديد نابع من اختيار الشعب، هو إعطاء المشاكل الأساسية المعطلة حلولها وتحقيق ما عجزت أو امتنعت عنه الأحكام محل الجدل في جميع مناحي الحياة العامة، انسجاما وتطبيقا لتطلعات أغلبية المواطنين.
ويربط العديد من الباحثين الموريتانيين بين واجب الدولة في حماية حدودها وواجبها في الدفاع عن مقدساتها الثقافية.
“إذا كان واجب الدول أن تدافع، لكي تستحق اسمها وشرعيتها، عن حوزتها الترابية والوجود المادي لسكانها، فإن عليها أيضا بنفس الإلحاح أن تدافع عن روح شعبها، الكائن المعنوي والاجتماعي، أي الخصوصية والتميز الثقافيين.
إن الشعب مستقل عن المجال الجغرافي، إنه موجود كتأكيد هوية وانسجام مجموعة مترتبة حول قيم معنوية واجتماعية. إن أي شعب يؤكد وجوده المستقل ويشارك بفعالية في التعددية المنتجة للتقدم بدفاعه عن خصوصيته.
إن الشعوب الصغيرة في العالم المتخلف مهددة في كينونتها بخطر الغرق في الفضلات الطاغية للثقافة الغربية. إن فرض ثقافة أجنبية ومكافحة الثقافة الوطنية، بمشاركة الأقوياء، يهدد بإيصالنا إلى حال اللاعودة: وضعية الاستلاب وقطع الجذور”9
ولا يعدم الباحثون تقديم أمثلة الذوبان الحضاري للشعوب المستلبة وكيف انقرضت روحيا وقيميا وهي موجودة.
إننا نعرف مصير حضارات الهنود الحمر، قبل الكولومبية. هذه الحضارات اللامعة انهارت بسبب الهجوم الشرس عليها من قبل الأوربيين. إن الهنود الحمر بعد فقدان ثقافتهم فقدوا توازنهم، بعد السيطرة عليهم واستلام الكنيسة المسيحية لهم وتعاملها معهم كأطفال، إنهم قد فقدوا كل طعم وكل ذوق للحياة وعاشوا في بؤس معنوي تعس.
إنهم لم يعودوا يستوعبوا أي شييء، ويتصرفون فقط كالآلات وفقدوا الذاكرة المباشرة. نتذكر الحادثة الشهيرة المثيرة للشفقة: كانت الكنيسة تدق الجرس عند منتصف الليل لتذكرهم بالواجب الزوجي، لأنهم إذا تركوا لمبادرتهم الخاصة حتى ذلك لن يطرق لهم بالا.
ويربط العديد من الموريتانيين بين بقاء الكيان الموريتاني بمدى محافظته على لغته العربية.
إن الحفاظ على الروح والثقافة الوطنية يمر بالحفاظ والدفاع عن اللغة العربية. إذا بقيت اللغة العربية في هامشيتها، محاربة على النسق الحالي، مع مباركة الدولة، فإن مصير موريتانيا قد ختم: شعب مسلوب سيفقد كل صواب ومعنى في الحياة وكل رجاء في المستقبل.
في ما يخص اللغة العربية يبدو أن هناك أحكاما مسبقة وعقد خارجة عن الزمن والعقل يصعب، موضوعيا، استيعابها.
إنه أصبح الآن من المتعارف عليه عند المربين والمفكرين أن أي شعب لا يمكن له أن يتفتق ويصل إلى النمو بدون لغته الخاصة. إن أمثلة اليابان والصين وفيتنام وماليزيا تبرهن بشكل رائع على دور اللغة الوطنية في التقدم والتطور، أمامنا إذا: إما مثل اليابان و الصين وماليزيا وإما نماذج هايتي و قوادلوبه. فلنختر بينها.
معارضون:
كلما أثيرت قضية اللغة العربية في موريتانيا يراهن الطرح التغريبي على رفع لافتة الفرنسية كعنصر محدد للأقليات الإفريقية متناسين إسهامات المجموعات الموريتانية الإفريقية في مقاومة الغزو الاستعماري واختراق اللغة الفرنسية وتحول قراها إلى قلاع حقيقية لمقاومة الثقافة الاستعمارية10.
تعددت مبررات رفض التعريب العملي من قبل النخبة المستغربة و كانت اليافطات التي يحملها معارضو التعريب هي أن التعريب سيتسبب في فقدان العشرات لوظائفهم وفي غلق الإدارة أمام الطلبة الجدد المفرنسين متناسين أن التمكين للفرنسية تسبب في تعطيل الآلاف المعربين الذين لم تفتح الإدارة أمامهم أصلا وتعمل المنظومة التربوية سنويا على تخريج المئات منهم ليزيدوا معدل البطالة.
وعادوا مجددا إلى تكرار سيمفونية الإقصاء والقهر الثقافي للأقليات بينما يعني تطبيق الفعلي لترسيم العربية وجوبا خلق الوعي بالذاتية الثقافية السليبة بمكوناتها المتعددة وإسهاماتها في إغناء التاريخ المشترك للبلد المتنوع.
وكثيرا ما لا تطرح بالنسبة للنخبة المستغربة إشكالية تطوير اللغات المحلية بإلحاح و إنما فقط متطلبات الحفاظ على الفرنسية مشجبا للتصدي للتصالح مع التاريخ والهوية الوطنية في تغافل تام عن بديهة أن الفرنسية دخيلة بالنسبة للمعربين و بالنسبة للأفارقة أيضا وهي لغة أجنبية لا يعني متطلب الانفتاح عليها ضرورة التمكين لها على حساب اللغات الوطنية.
معركة الهوية : مخاطر التسييس والانغلاق
إن واجب الترسيم الفعلي للغة العربية بموريتانيا لغة إدارة وعمل وكجزء حاسم من التعاطي مع إشكالات الهوية باتت تطرح بإلحاح وفي ظل تجذر الخرق يبدو الخروج عليه نوعا من العبثية مؤلم ولكنه مطلوب. وتبدو واجبات النخبة أكثر تأكيدا في الاضطلاع بدورها في هذا السياق.
إن قضية التمكين للعربية يتعين انتزاعها من لوثة التسييس الذي أضر كثيرا بالنظرة إلى العربية وبات بعض ينظر إليها لغة يعني تعميمها قهر الأقليات مع أن هذه الأقليات لم تعرف يوما قبل الاستعمار إلا العربية لغة علم وعمل حتى ولو راهنت بعض نخبها المغربة على التعلق بجدار سميك من الدفاع عن الفرنسية لا دفاعا عن اللغات الوطنية بل سعيا خالصا للحؤول دون التمكين للعربية.
وكثيرا ما عانت إشكالية اللغة من التوظيف السياسي في موريتانيا مع أن الإشكال في هذا الصدد هو إشكال قانوني بامتياز، وفي حالات عديدة تتهدد الاعتزاز بالهوية مخاطر الإقصاء للآخر والانغلاق على الذات وقد أخطا الكثير من المدافعين عن اللغة العربية في موريتانيا وباتت أطروحاتهم تشي بقدر من الانغلاقية والفوقية بل والعدائية حيال اللغات الاخري وحيال الانفتاح وأساءوا للطرح بقدر ما أساء المتنكرون لأحقيتها.
إن تكريس العربية بهذا المفهوم العملي والقانوني يحمل في حد ذاته تطويرا للغات الوطنية لأن العملية تعني بالأساس وفاء المجموعة الوطنية لقيمها الذاتية التي تشكل ضمانة استمرارها وخشبة خلاصها من كل سلب واستلاب حضاري، ومن هذا المنظور قد يفهم تلقائيا أن أية عملية استعادة وتثمين للهوية الثقافية تشمل وجوبا تعزيز المكونات الثقافية الأخرى من بولارية و سوننكية ولفية و ويتم النظر إلى التمكين للغة العربية كجزء من مسار تصالح مع المكونات الذاتية بما فيها اللغات الوطنية.
ولا إشكال في ضرورات التعايش بين اللغات وواجب التطوير المستمر للغات الوطنية التي تم في الثمانينات تأسيس معهد لتطويرها إلا أن طبيعة الأداتية والتسييس وفق المقاربات التي كانت طاغية حالت دون استدامته وإعطائه الزخم المناسب والدور المطلوب.
ما العمل؟ آليات التصالح مع الذات والقانون
إن المفارقة التي كانت محل مساءلة طيلة الصفحات السابقة تقتضي التسلح بالشجاعة اللازمة والوفاء للمطلب الجماهيري الملح والواجب الدستوري من قبل السلطات الموريتانية بالعمل على التمكين للعربية في محيطها الطبيعي.
غير أن المقاربة الشاملة تستدعي في البدء تخليص العملية من كل شوائب الاقصائية و الاستلاب والسياسوية ومباشرة الاجرءات التي بدونها تتحول عملية تكريس التعريب من محطة متدرجة ضمن محطات استعادة هوية أمة بما فيها تطوير اللغات الوطنية إلى مجرد سيطرة مكونة على أخرى مما يضر طابع التناغم والتكامل بين هذه المكونات.
من هذه الإجراءات:
- العمل على تكريس التصالح مع المقتضيات القانونية بترسيم اللغة العربية فعلا لا قولا لا سيما في الإدارات؛
- مراجعة النظام التربوي بما يكفل المزيد من الاهتمام بالعربية وضمان التواصل بين الأجيال المختلفة (الشعب الواحد باللغة الواحدة)
- تطوير اللغات الوطنية بإعادة افتتاح المعهد الوطني لتعليم اللغات وتأهيله و تشجيع المراكز والبحوث حول التاريخ الوطني في تعدده البناء وثرائه المشهود؛
- تكريس سياسة تعليمية منفتحة تجعل من تعلم اللغات الأجنبية أولويتها دون إحلالها المكانة الرسمية؛
- تشجيع الاندماج المجتمعي وتعزيز أبعاد التنوع؛
- تدعيم البحوث حول الهوية الوطنية ومناقشة أبعادها دون تابوهات ولا تسييس.
البيبليو غرافيا
1) موريتانيا في الذاكرة العربية/د حماه الله ولد السالم/الطبعة الأولى /مركز البحوث والدراسات العربية/بيروت/لبنان2005 – مركز دراسات الوحدة العربية /ط الاولى/بيروت لبنان/2005
2) السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية/محمد ولد عبدى/دار نينوى للنشر /سورية/دمشق2009
3) الامارات والنظام الاميرى الموريتاني/د محمد المختار ولد السعد/الطبعة الأولى/ نوفمبر2007
4) المجتمع البيضانى فى القرن التاسع عشر/محمد ولد محمدن/منشورات معهد الدراسات الافريقية2001
5) تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية/د حماه الله/مطبعة النجاح الجديدة/الدار البيضاء/2007
6) الفتاوى والتاريخ/محمد المختار ولد السعد/دار الغرب الاسلامى/الطبعة الاولى2000
7) موريتانيا المعاصرة/سيد أعمر ولد شيخنا/دار الفكر/نواكشوط موريتانيا2010-
8) موريتانيا على درب التحديات/المختار ولد داداه /كارتالا/باريس2006
9) صحراء الملثمين /د النانى ولد الحسين/ دار المدار الاسلامى /البعة الاولى /2007
10) حياة موريتانيا/التاريخ السياسي/المختار ولد حامد/دار الغرب الاسلامى/الطبعة الاولى/2000
11) قبايل البيضان عرب الصحراء الكبرى /الشيخ موسى كمرا/تحقيق د حماه الله ولد السالم/دار الكتاب العلمية /الطبعة الأولى/2009
12) الفقه والمجتمع والسلطة /يحي ولد البراء /المعهد الموريتاني للبحث العلمي.
13) الزوايا فى بلاد شنقيط في مواجهة الاستعمار ايزيد بيه ولد محمد محمود/المطبعة الوطنية/الطبعة الثانية 2003
14) التوغل الاستعماري في موريتانيا/الرائد جلييه/ترجمة محمدو ولد حمينا/الطبعة الأولى /دار الضياء /2007
15) موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع/مجموعة باحثين /مركز دراسات الوحدة العرب
16) Tribus ethnies et pouvoir en mauritanie \Philip marchesin\Editions KARTHALA paris